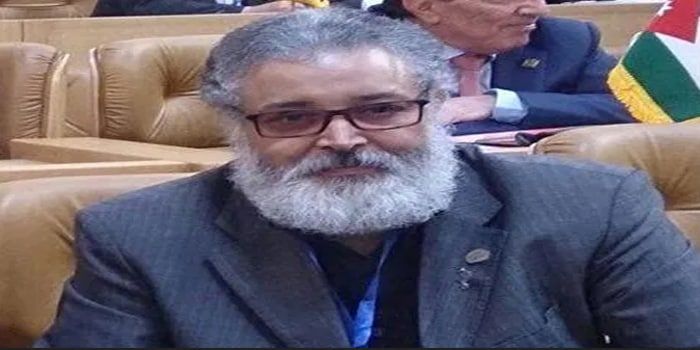هل الصورة عين الوجود؟ فلسفة السينما صدرائياً
ادريس هاني:
أثارني حديث فلسفي حول الصورة والسينما والفلسفة، أثناء فعاليات توقيع كتاب “صور الوجود في السينما والفلسفة” للمفكّر المغربي الصديق د.محمد نور الدين أفاية، نظمته مكتبة الألفية بالعاصمة الرباط مساء الأربعاء 21-12-2022، في ندوة أدارها د.يوسف توفيق صاحب “حكايات أمازيغية من منطقة الريف”، وبحضور د.نور الدين الزاهي قارئاً ومعلّقاً.
أهمية هذا الحدث هو اقترانه بموضوع فائق الأهمية، لا من الناحية الثقافية العامة ولا من الناحية الفلسفية، كنا بحضور ثلاثة فرسان أو فلاسفة صورانيين إن صحّ الوصف، هم كلّ من نور الدين أفاية الذي أنجز بالفعل ملحمة في فلسفة الصورة والسينما منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبها سيكون للمكتبة العربية أساس تنظيري في هذا المجال الحيوي، مثل “الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل”، “الصورة والمعنى: السينما والتفكير بالفعل”، “معرفة الصورة، في الفكر البصري، المتخيل، والسينما”، والكتاب الأخير المحتفى به وكاتبه: “صور الوجود في السينما والفلسفة”، إضافة إلى نورد الدين الزاهي وهو من المشتغلين الجادين على الصورة والتشكيل، مادّاً المكتبة العربية بترجمات نفيسة مثل “حياة الصورة وموتها” لرجيس دوبريه، و”أنثربولوجيا الحواس” لدافيد لوبروطون، وأعمال أخرى له كـ”الصورة والآخر” و”من الصورة إلى البصري”، وجدير بالإشارة إلى د.سعيد بنكراد الذي كان حاضراً كمستمع، وهو من الصورانيين أيضاً في نظري، من خلال أعمال وازنة في مجال التحليل السيميائي، مثل “تجليات الصورة: سيمياء الأنساق البصرية” و”الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة” الخ.
الكتاب إذاً ملحمة في تاريخ الفكر السينمائي، يتتبع مجمل الأفكار التي جعلت من الصورة والمتخيل والسينما بثيماتها الزمنية والحركية وتقنياتها ومدارسها، ومجمل الاستيهامات موضوعاً لفلسفة السينما، ويستحق الكتاب وقفة وقراءة، من حيث ندرة اهتمامه، ومن حيث رفده للغة الضاد بفلسفة الصورة، ما يؤكد، ونحن في اليوم العالمي للغة العربية، بأنّها متفاعلة مع أعتى مشكلات الحداثة وقضاياها من دون تكلّف أو خُوُر. قد نعود إلى الكتاب في الوقت المناسب بعد إنهاء فصوله، لكنني سأغتنم هذه الفرصة لأتفاعل مع موضوع الصورة والسينما، لأبوح ببعض ما لديّ في موضوع الفلسفة والصورة، الفلسفة والسينما، وقضايا ذات الصّلة.
+ + +
ليس مزحة إذن حين يقرر فوكو- والتقرير ليس من شأن الفلسفة – أنّ القرن العشرين إما أن يكون دولوزياً أو لا يكون، يكفي أنّه فتح مجالاً واسعاً للفكر السينمائي، في عصر هو حقّاً من أكثر العصور خضوعاً للنزعة السينمائية، فلقد سافر دولوز بالفعل بين المفكر فيه واللاّمفكر فيه، إنّها لحظة الانعتاق الكبرى من الهيغلية التي فرضت شكلاً من أشكال بيت الطّاعة بعد أن حررت القبيلة الفلسفية من الأسر الكانطي، والحقيقة، هي أنّ هؤلاء لم يتحرروا بالفعل مما سبق، وإنما تمردوا على الحصر والحشر الفلسفيين بحثاً عن التركيب، لأنّنا سنجد إعادة القراءة مستمرة مع هذا الجيل الذي هو مدين في هذا التمرد لنيتشه.
ماذا كان في وسع العالم المعاصر أن يكون لولا السينما؟ فالسينما ساهمت في تحديد صورة وجودنا، لأنّها شكلت رافداً ليس للنخبة التي عاقرتها من خلال تساؤلات خاصة، بل لأنّ السينما دخلت مرحلة الاستهلاك العمومي، دخلت البيوت، باتت وسيلة تربوية جماهيرية، باتت وسيلة للسيطرة والتحكم والصدمة والقلق.
قلت إنّنا إزاء صورانيين، لأنّ الفلسفة وعلى الأقل منذ كانط تحررت من سلطة النومين، ومنحت للذهن سلطة تقديرية لكنها مراقَبَة، حيث هذا الواقع هو واقع تلعب فيه الفاهمة دوراً كبيراً فيما يعرض من ظاهرات، وهنا وبتعبير كلاسيكي تلعب الواهمة دوراً أساسياً. ربما كان هذا أمراً معقداً في عصر هيمنت عليه الميكانيكا، لكنّنا اليوم إزاء انقلابات كوبرنيكية في العلم، أمكننا من خلالها أن ندرك أنّ ما يمكن أن نعتبره صورة موضوعية لا يصحّ حتى فيزيائياً، فبالعودة إلى جاك لاكان، يمكن الحديث عن تداخل الموضوعي بالذاتي، والمثال هو جهاز التصوير التقني الذي سينقل صورة للقوس الذي يتجلى في السماء بألوان الطيف، كما هي، بينما تلك صورة كوّنها انطلاقاً من ذلك الشيء الماثل أمامنا وليس كما هي حقيقته في الخارج، إن أخطاء بارالاكس هي أخطاء، إن شئت، بها نحيي، وبها تتقوم صور العالم كما نتمثلها لا كما توجد في ذاتها.
في إطار الوعي التركيبي بالعالم، أوكد أنّ السينما كحدث أو ثورة بصرية تجاوزت الفلسفة والعلم معاً، لأنّها تعاطت مع العالم بكل أنحائه ومع الإنسان بكل أنماطه، ففيها تلتقي مفاعيل الإنسان العاقل، والصانع، واللّعبي.
لم تقف السينما عند معالجة سائر المباحث الكلاسيكية للفلسفة، كالوجود، والمعرفة، والقيم، بل استدمجت كل تلك المباحث، وتحققت معها ثورتها العبر- مناهجية، وهذا من شأنه أن يفرض على الفلسفة أن تلتفت إلى هذا الحدث البصري، وتُسائله من خلال مفاهيمها، لتتجاوز البعد الفرجوي الماتع إلى ما وراء الفرجة، فالصورة ليس فقط تمتعنا بل هي أحياناً تستفزنا، بقدر ما تخصب المتخيل بأنماط من التفكير يصعب أن تحدث خارج السينما.
قبل أن ندخل السجل الحديث للفلسفة والسينما، سأطرح سؤالاً قد يبدو غريباً، لكنه سيفتح باباً لإعادة قراءة ماضي الفلسفة فيما لم تفكّر فيه مباشرة، لكنها فكرت فيه بشكل آخر، إنّ السينما وحدها استطاعت أن تجيب عن السؤال البرغسوني حول الديمومة، مهما بدا من تقطيع هامت فيه السينما في بداياتها. استطاعت السينما أن تعزز من هذه البرغسونية، لحظة تعايش الحاضر مع الذاكرة، تداخل الأزمنة، السفر في الزمان، تمثل لحظة بروست الاستذكارية القصوى. إنّ السينما هي الصورة، وهي الوجود بأنحائه، وهي الحركة، وهي الأنوار، وهي فعل التلقي، هي التأويل، إنّها مساحة لإعادة إنتاج المعنى فيما لم يكن وارداً قبل الأخوين لوميير، إنّ فكرة السينما سابقة على الحدث السينمائي، هي بنت الخيال، ففي متخيلنا توجد السينما منذ أقدم العصور، الكائن بما هو استيهامي، هو سينمائي بامتياز، الحدث السينمائي لم يفعل سوى أن حقّق تقنية إعادة إنتاج الاستيهامات خارجانياً.
وأمّا سؤالي، فيتعلّق بملاصدرا والسينما. هذا ليس فقط وفاء للحكمة المتعالية، بل لأنّ ولعي بالصورة والحركة والخيال ساهما في اقترابي من الصدرائية، وبه أقول إنّ ملاصدرا هو من أبرز فلاسفة السينما حتى قبل الحدث السينمائي، وكنت أتمنى لو تأمّل دولوز فكر الصورة في الحكمة الإشراقية والمتعالية، إذن لاهتدى إلى ما كان قد اهتدى إليه، وهو يبحث في البرغسونية عما يجعلها مفاهيم سينمائية بامتياز، مصالحة بين السينما والبرغسونية، لكن كان أحرى المصالحة بين السينما وتاريخ الفلسفة كلها، وسوف لا أستغرق الكثير للبحث عن تلك العلاقة وهي:
إنّ التطور التقني السينمائي أضفى على المشهد أبعاداً إشراقية، لعبة الأنوار المتدفقة، والتي سنجد لها إشارات في بحث بعض المدارس في المونتاج. فالسينما تسافر بك في الزمان، تضعك أمام كون هولوغرامي، لعبة الألوان المذهلة، تداخل الصور والأمكنة والأزمنة.
قبل ذلك أحبّ أن أعود إلى عنوان كتاب د. أفاية: صور الوجود، وسأبدأ بعلاقة الصورة بالفلسفة، صور الوجود تنقلني إلى أنحاء الوجود، إلى وجود أكثر من نحو للوجود، إلى تكاثر الوجود، إلى ما هو عيني وما هو عارض، إلى امتياز الوجود بحسب مراتبه وإن توحّد في أصله. الوجود متمنع عن التعريف، لسبب بسيط، أنّ لا شيء يسبق الوجود، أو ينكشف إلاّ بالوجود، لكننا مع هيدغر في تتبع تاريخ الوجود، نجده انكشاف. عند الإشراقي الوجود هو نور، هذا النور قد يُحجب بخفوته حدّ الظلمة، وقد يُحجب بسطوعه الشديد حدّ الخفاء، لكي أعرف شيئاً وجب أن أتصوره، وحتى الوجود سندركه في خبرتنا وحضورنا، في لغتنا: اللغة بيت الوجود، لكن أليس الأولى أن نخرج من كل هذه الأخطاء “البرالاكسية”، لأنّنا إزاء حدس الوجود، الوجود في صورته والصورة في الوجود، من يسبق من؟ الحل عندي أنّ الصورة هي عين الوجود.
فلسفة ملا صدرا، لا سيما في المعاد، تمنحنا إمكانيات ومفاهيم هائلة في التفكير في الصورة وفلسفة السينما. وإن كان ملاصدرا قد نزع إلى تأصيل الوجود مقابل اعتبارية الماهية، إلاّ أنّ الماهية غير منفكة عن الموجود، لأنّ الموجودية تقتضي التلبس بالماهية، وإن كان الحكيم اعتبر أن البارئ ماهيته هي عين وجوده، فذلك لأنّه لا بديل عن قول ذلك، وإلاّ أثبتنا الإثنينية.
الصورة في الحكمة المتعالية هي الكمال، وحاجة المادة إلى الصورة حتميّ، فمهما طرأ على الجسم من آفاة فوحدة الصورة منحفظة، وهكذا حلّوا مشكلة انحلال الأجساد بعد الموت، وقضية البعث والمعاد، فالكائن بصورته لا بمادته، حيث يرى الحكيم أنّ “کل مرکب بصورته هو هو لا بمادته”.
وتبلغ دقّة ملا صدرا في اعتبار التّشخّص والوجود متحدين. إنّ الفلسفة الإشراقية قبل هيدغر لمّحت إلى الوجود كظهور، وها هو هنا تشخّص، والخلاف عند ملاصدرا بين التشخص والوجود هو إسمي فقط، ويستثني هنا العوارض المشخّصة، لأنّها متبدلة وأمارة دالة فقط على الهوية الشخصية لا بأعيانها، والأمر نفسه بالنسبة للعوارض المادية، فهي مشخصات تعكس حاجة الشخص إليها بحكم نحوه الوجودي المادي.
إنّ للخيال والقوة الخيالية-مربط فرس الصورة- وضعية خاصة في الحكمة المتعالية الصدرائية، وانظر كيف خطّأ ابن عربي أو حدّ من العقل الغريزة ومنح الخيال صفة المعصومية، إنّ الخيال هو جهاز موضوعي لنقل الصور وتخزينها، وسوف نجد ملامح البرغسونية في نص صدرائي، لا يكاد يختلف عما منحه برغسون للذاكرة في “الذاكرة والمادة”، فهي لا توجد في الدماغ.
وهذا ما نجد مثيله عند ملاصدرا حول القوة الخيالية، حيث القوة الخيالية جوهر قائم بذاته “لا في محلّ من البدن وأعضائه، ولا هي موجودة في جهة من جهات هذا العالم الطبيعي، وإنما هي مجردة عن هذا العالم واقعة في عالم جوهري متوسط بين العالمين، عالم المفارقات العقلية، وعالم الطبيعيات المادية”.
إنّ هذه الالتفاتة واحدة من خاصيات الحكمة المتعالية الصدرائية التي نسبها الحكيم إلى اجتهاده الخاص: “وقد تفردنا بإثبات هذا المطلب ببراهين ساطعة وحجج قاطعة”.
إذن صورة الشيء هي حقيقة وجوده، وتشخص الصورة يتحقق بوجوده الخاص. وإنّ الخيال هو خزان الحس عند ملا صدرا، وسنجد أنّ ملا صدرا يعتبر آخر ما يتبقى من الجسد بعد هلاكه هو ما يسمى بعجب الذنب، وهكذا تنوعت آراؤهم حول سر بقاء هذا العظم، فسماه بعضهم بالعقل الهيولاني أو الهيولى أو النفس التي تنشأ عليها النشأة الآخرة كما ذهب الغزالي، أو العين الثابت من الإنسان عند صاحب الفتوحات، ليخلص صاحب ملا صدرا في مفاتيح الغيب بالقول، أنها القوة الخيالية: “و عندنا: القوة الخيالية، لأنها آخر الأكوان الحاصلة في الإنسان من القوى الطبيعية”.
وإذا تحصّل أنّها القوة الخيالية، والخيال صدرائيا هو خزان الحس، أمكن القول بأنّ آخر ما يتبقى هو خزان الصور، ومنه تتحقق النشأة الأخرى.
وعليه، مبعث المعاد فلسفياً فتح مجالاً لفلسفة الصورة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار انقلاب أحوال العوارض المشخصة، ومراتب الوجود وأنحائه، والحركة الجوهرية التي مكّنتنا من إدراك الزمان في عين أصالة الوجود المراتبي، لا كشيء مستقل بوجود موضوعي خارجي، سندرك أنّنا أمام مادة حكمية دسمة لاستيعاب كل ما تحتويه السينما من مفاهيم الصورة والحركة والخيال.
+ + +
بعيدا عن الحركة المتعالية وأهمية الصورة، ماضي النفس وقد استدعت بدناً لتُدبره، ومآلها بعد اكتمال الخيال واتحاد سائر الملكات، والفعل والانفعال، الرغبة والتحقق، نعود إلى عصر السينما والخطاب السينمائي في الفلسفة الحديثة. فلا شكّ ما كان لدولوز من أهمية في مجال الفكر السينمائي، حيث تكمن أهمية المقاربة الدولوزية في أنّها استحضرت المفاهيم الفلسفية القديمة عن الحدث السينمائي، واكتشفت في السينما ما اكتشفه سلفه في الشعر أو التشكيل والمسرح والرواية، فلئن كانت الرواية تذكرنا، فالسينما تعيد تشكيل الواقع بصورة تمثل الذاكرة بشكل يحقق مفهوم الديمومة البرغسوني، فالأزمنة سينمائياً متواشجة، هي تعكس واقعنا المركب، وهذه هي خصيصة التأثير النيتشي في هذا الرّعيل.
عندما كنت طفلاً، و مازلت، كنت أرى في السينما ما كنت أرغب أن يكون الواقع على غراره، جعلتنا السينما نرى الواقع كتجلٍّ سينمائي، التقطيع والمونتاج هو فعل الخيال نفسه، حتى الصورة السينمائية هي فيزيائياً مقطوعة، هي لو كانت لنا أبصار غير أبصارنا، تدفق سريع لصور ثابتة، إنّما قصور العين يؤهّلها لرؤية الحركة، وتلك هي المفارقة الفيزيائية. فلو ازدادت نسبة حدّة بصرنا – وكان بصرنا حديداً – لرأيناها عرضاً وشريطاً لصور ثابتة.
تابعنا السينما في معظم أطوارها، وأنماطها، من الصامتة – شارلي شابلان- حيث زاد قصور الصورة وتقنيتها من جمالية المشهد، مع هيتشكوك الذي جعل الخيال السينمائي يستفزّ خيال المتلقي ويشركه تشكل المعنى المفقود، في شبه ذُهان سينمائي.
إنّ السينما واقع مرن، يمنحك إمكانية تأويل الصورة وإعادة إنتاجها، حتى الصورة التي يصنعها التقني، تصبح ملكاً للمتلقي، ينشئها كيفما يشاء.
السينما هي حركة، لكنني مدمن أفلام الحركة، هي زيادة في الحركة، لها نصيب من فلسفة السينما، تأمّل في عبقرية الجسد، وأيضا تأمّل في مكامن ضعفه. في أفلام الحركة، استفزاز لثأر الخيال. ثأر الخيال من واقع قلّما تنجح فيه العدالة. فكرة منفذ العدالة الخارج عن القانون، فلسفة الصراع، تدبير العنف. الأمر نفسه بالنسبة لسينما الخيال العلمي، هي مساحة لتهريب تساؤلات تلاحقها سلطة الباراديم العلمي، هناك في السينما نقف على مشاهد نسبية الزمن، الأوتار الفائقة، كل فيزياء المستحيل عند ميشيو كاكو ونظراؤه، لا شيء مستحيلاً في السينما، تضعك بعض الأمثلة إزاء صدمة إبستيمولوجية مباشرة. الحاجة إلى السينما هي حاجة تعويضية، وهي شكل أيضاً من الثأر من الواقع، مجال لإعادة العلاقة مع اللاّمفكّر فيه، وهي أيضاً الأمل الذي يأبى الواقع أن يقبله، لنقل إنها العلاقة الممكنة بين السينما والفلسفة التفاؤلية.
ومع تراجع قاعات السينما، إلاّ أن السينما بقيت حاضرة بقوة، حاضرة بأشكال من التوزيع غير تقليدية، تخمة سينمائية مازالت تعيد تشكيل العالم. وتماماً كالواقع، فالسينما تخضع لمحتويات مختلفة وتناقضية، فمن يهيمن على السينما يهيمن على العالم.
كتاب د. محمد نور الدين أفاية، يلبّي هذه الرغبة، ويحقق هذه البُلغة في مجال تكوين رؤية جامعة مانعة في مجال الفكر الصوراني وفي فلسفة السينما، وهو بالاحترافية البيداغوجية نفسها -المعهودة على جيل فلسفي جادّ- التي سبق وعالج بها الفكر التواصلي عند هابرماس، وقضايا أخرى، بدل الوسع كلّه، وعزز الممارسة الفلسفية المغربية والعربية بأنماط أخرى من التفكير.