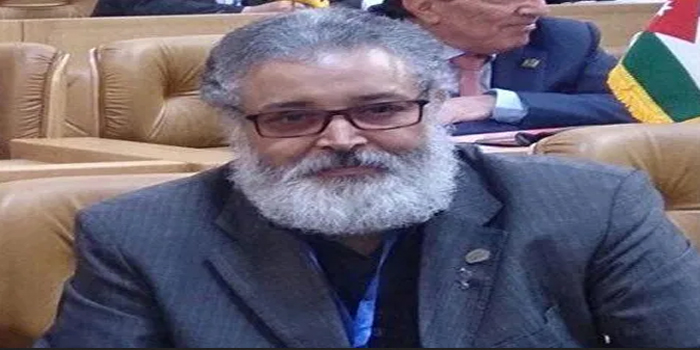عن تاريخ الوجود
ليتنا نترك التاريخ جانباً، لا ندخله في لعبة التقارع السياسي، التاريخ حين يصبح مادة بيد الإيديولوجي، يقضم أنفه، ويحوّله إلى رسوم متحرّكة على هوى المؤرّخ المتحرّق، هل يمكننا أن نحافظ على العدالة الهيستريوغرافية حين نباشر النميمة التاريخية بعصبية؟
ليس الحدث وحده ما يتطلّب تأنّيّاً، مهما بدا سريعاً، فالآنال تهتمّ بالموجات البعيدة والبنى البطيئة، لكنه المؤرّخ ذاك الذي يريد أن ينهي مهمّة التاريخ كلّها في مدوّنته، فهو لا يستعجل الحدث فحسب، بل يختزل التاريخ كلّه في خبرته أيضاً. تبدو المشكلة هنا مزدوجة: مشكلة تاريخ شديد التعقيد، ومشكلة المؤرّخ المأخوذ بالعصبية.
هو إذن شديد التعقيد، لأنّنا أحياناً نصادف تاريخاً يتقوّم بالجغرافيا، كما نصادف أحياناً جغرافيا تتقوّم بالتّاريخ.
في ممارستنا التأريخية نخلط بين حقائق العرق والسلالة من جهة وحقائق الدول والأوطان من جهة أخرى.
نقع في أمراض الكتابة التاريخية التي واحدة منها فقط: الطريقة النازية في التأريخ والتربية على الزيف.
تحتضن الجغرافيا المادية أنماطاً من الاجتماع والنشاط البشريين، تقوم بذلك الجغرافيا البشرية ومن ثمّ الثقافية، وها قد اكتسبت الجغرافيا تاريخها.
ماذا تعني الجغرافيا من دون الإنسان، ولا حتى التاريخ نفسه إن لم تكن هذه الكرونولوجيا التي تحصي آنات الاجتماع الثقافي؟ أرأيت كيف أنّنا حين نقترب كثيراً من التاريخ ومن الجغرافيا تنفلت منّا أسئلة الوجود؟ إلى أي حدّ يا ترى تساهم الجغرافيا والتاريخ في نسيان الوجود؟ ها نحن إذاً أمسكنا بصلب المشكلة الأنطلوجية في معمعة الافتتان بسلطة الجغرافيا وأساطيرها.
كم نحتاج من تأويل لأساطيرنا المحدثة، لكي نقف على الطرائق الأكثر بهلوانية في تجاهل الوجود؟ إنّنا نمنح أساطيرنا المحدثة كل هذه السّلطة، والتي تمنحنا بدورها قدرة فائقة على ممارسة الاستغباء الذّاتي، باعتبارنا كائنات متطورة في الوجود.
لكن، هل يا ترى، نحن بالفعل كائنات متطورة في الوجود، أم بالأحرى كائنات متطورة في مغالطة الوجود؟
ثمّة عُصاب جماعي يجد في الكتابة التاريخية ملاذاً آمناً من كل رقابة إبستيمولوجية. التحقيق التاريخي يساوي نميمة يعززها النظام التربوي النازي، وفي النهاية إحساس جماعي عارم بالنشوة، لكن أين هو الكائن في كل هذه الصناعة؟ أين الحرّية؟ أين الكرامة؟ أين المجد العظيم لتاريخ الكينونة؟ أين نوجد في جغرافيا الوجود؟ ففي هذا الاستلاب التّاريخي والجغرافي، ننسى أنّ الكائن أعلى مقاماً من الجغرافيا والتاريخ، كائن يضفي حماقته على الأحياز ويمنحها امتداداً في التّاريخ.
وضع هيدغر مانشيتاً في محاولاته من دون أن يفصّل. الرغبة في استعادة السؤال الأنطولوجي صدمتها الجغرافيا السياسية المتحركة. اقترب بعض الشيء من دون أن يتمادى، بحثاً عن أنطلوجيا جيوسياسية، لكنه لم يتخطّ الوضعية التاريخية للجغرافيا السياسية الجرمانية؛ أراد أن يعزّز الأنطولوجيا المفقودة بجغرافيا سياسية نازية. عاد الأمر كما بدأ، هذه هي معضلة البحث في الوجود في شروط جيوسياسية إذعانية، معضلة التّداني بالمتعالي. تساهم الجغرافيا السياسية في محق الوجود، انهارت المعايير، فبدا الإنسان ابن ضربة حظّ جغرافي أو هَجْعَة تاريخانية.
خلاصة هذه الشّقشقة، أنّ الإنسان يفقد قوامه الأنطولوجي متى أصيب بالعُصاب التّاريخي، ويزداد هذا الوضع المرضي حدّاً ينتهي بنوع من الذُّهان الجماعي. والحل؟.. الزم كوخك، وافتح خريطة الوجود بلا حدود، ترقّى قدر ما تتيحه إنسانيتك حين تدرك أنّ الإنسان يرقى بقدر خبرته في الوجود:«أتزعم أنك جرم صغير….. وفيك انطوى العالم الأكبر»
كاتب من المغرب