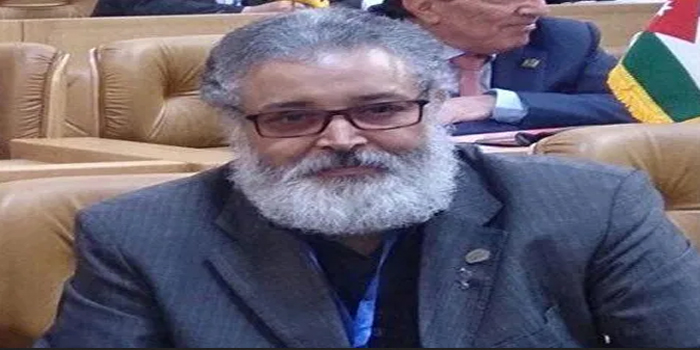التّاريخ كرواية أم التاريخ كاعتبار؟
لا بدّ من الحذر من العملية التأريخية، لأنّها تكاد تكون إشكالية، متى جهلنا الفارق المنهجي بين الخبير والراوي والمؤرخ، فالخبير معني بقضية ما، في مخبر ما، كالكيميائي أو المتخصص في الأسلحة القديمة وألبسة القرون الوسطى، كما يُعرّف الراوي بمن يروي قصصاً محبوكة بناء على معلومات محققة، ثم المؤرخ الناظر في السوابق واللواحق، قبل أن يستنتج منها عبراً.
لقد ورثنا نزعة ثورية، حتى أنّنا خالفنا التّاريخ المقرر، ونبذنا كل شكل من أشكال القهر الفكري.
لا زلت أذكر حينما عدنا من العطلة ذات حقبة، يسألنا الأستاذ ونحن لا زلنا أطفالاً: ماذا استفدتم من الفصل الدراسي السابق، كنا بمادة التاريخ، أجاب الأطفال على قدر طفولتهم، وكان منهم متملقون مثلما أرى كباراً يتملقون اليوم على درب المعرفة، لسلط باردايغمية متصلبة، ظاهرة وخفية، ضحايا إعادة الإنتاج السوسيو- ثقافي وغسيل الدماغ الذي يؤمنه النظام التربوي الشمولي.
..لما بلغني الدور قلت للأستاذ: إنّ ملاحظتي، هي أنّ كل ما تلقيناه خطأ في خطأ. شعر الأستاذ بحرج وفضول، ولحق به جمهور الأطفال الأغبياء، قال: الله أكبر، طيب، أين يكمن الخطأ؟ فبدأت أحلل ما أراه، وأهمه لا يكمن في التفاصيل، بل في أنّني حتى اليوم أكتشف أنّ ما فعلته يومها يدخل في النزعة الثورية الطفولية ضدّ قهر الاستغباء.
لا أزعم أنني أستطيع أن أقدم رؤية مقنعة في مقالة واحدة، لا سيما حول التّاريخ، ولن أزعم بأنّ حقائق التاريخ يمكن احتواؤها كموضوع للبروباغاندا. التأريخ له مقام آخر، ومتلقي يدرك هسيس النصوص وغوايتها، وعدوانية الخطاب ومخاتلاته. نحن نميّز بين التاريخ والأيديولوجيا، بين الديكتاتورية المنفصلة والديكتاتورية المتصلة، بين الاستبداد المعزول في الوجدان والشمولية الجاثمة على العقل.
ولا بأس أن أشرح وأوضح ذلك، مادام الواقع العربي يفرض علينا تقديم تشريح حيويّ لمعضلة العقل.
إنّ ما أسميه الديكتاتورية المنفصلة، هي تلك الديكتاتورية التي تكبح جماح التحرر، وتفرض قيوداً مادّية على المجتمع، وتناهض حرية التعبير، لكنها تظل معزولة وجداناً، منفصلة حينما يتعلق الأمر بالضمير، متموضعة هناك، لا نراها سوى عند مصارع الاحتكاك، لكن الديكتاتورية المتصلة، تخترق الضمير، وميكانيزمات التفكير، وتخلق عبيداً لا يتقنون الاختلاف، إنه الاستبداد العاري بتعبير برتراند راسل، أو الاستبداد الذي يذهب بالراحة الفكرية كما وصفه الكواكبي أو الشمولية التي ترهنك وترهن دماغك، عبيد في صورة أحرار، خاضعون في صورة ثوار، معتدون في صورة متظلّمين، ضُعفاء في صورة غاليغولات.
تكمن نسبتنا من التحرر في أن ما كان يسمى بالتربية الوطنية لم يعد مقرراً، نظراً لتمرداتنا الطفولية، وهي مادة ذات معامل صفري لا يهش ولا ينشّ، وهكذا نشأنا على معاكسة كل ما يأتي به المقرر. ولقد أضفنا إلى هذا التقليد الانعتاقي، تقليداً آخر يتعلّق بتمثّلنا للمدرسة العدلية في التفكير، حيث ناهضنا الانتهازية في السياسة والفكر معاً، ففي العملية المعرفية والبرهانية، لا نقبل بالمقدمات الفاسدة، بل لكي تكون النتيجة عادلة وجب أن تكون المقدمات عادلة أيضاً، وهذا ما خالفنا فيه السياسات والفكر الشمولي (التوتاليتاري) ذلك الفكر الذي يقوم على فكرة الكذبة النبيلة التي اجتاحت النزعات الشمولية المعاصرة، وهي الكذبة التي تعتمدها الشموليات لتمرير حقائق بلا توثيق، وأحجيات بلا تأمّل. ولأنّ الكذبة النبيلة تستمد مشروعيتها من نبل الغايات، فإنّها تتوسل أساليب الإقناع المغالط، أي الأيديولوجيا الرثّة التي تتساقط لأوّل وهلة حينما تقف أمام التقاليد العلمية والنقدية بشروطها وأدواتها الصارمة.
لا يمكن أن نخلط بين التأريخ والرواية، فوظيفة المؤرخ هي الاستنتاج والعبرة، ووظيفة الراوي هي السرد، لكن من يا ترى يحسم في أمر الوثيقة؟.. إنّه الخبير. ولعلنا نلاحظ أنّ غياب هذا الميز يسقط الراوي في التباسات كبيرة، لعل أهمّها إهمال “تاريخية”المؤرخ، سياقه، سياق الخطاب، الخلط بين الأزمنة، عدم الوقوف عند النماذج التاريخية المهيمنة زمن الحوادث. سيصبح التاريخ أحجيات، إلى حكايات الظاهر ببرس وعنترة بن شداد وسيف بن ذي يزن كما كان يرويها صديقي الحكواتي المرحوم أبو شادي في مقهى النوفرة. كانت حكايات للتسلية على فناجين شاي “اكرك عجم” ونفث دخان الأراجيل، بينما كنت أتأمّل المشهد ورمزيته الذي يحيلني إلى تاريخانية المكان وشعريته في الوقت نفسه.
يدرك أبو شادي أنّه يؤدي دوراً مشهدياً للتسلية، لكن هناك من يسرد الأسطورة كتاريخ يقتضي الإذعان. أبو شادي في ذروة الحكاية يدرك وظيفته، لكن نُخباً تؤرّخ بسذاجة ولا تعرف حدود الحقيقة والزيف. هذه الظاهرة هي تمرين خطير يستهدف العقل العربي، بل يستهدف الدّماغ، ويضيف إلى مأساتنا في التحرر الاجتماعي عبودية إضافية أخرى، هي غياب التحرر العقلي، ارتهان الدّماغ للسّردية القائمة على الكذبة النبيلة، على الرغم من أنه لا وجود لكذبة نبيلة، لأنّ الغايات اليوم لم تعد هي نفسها نبيلة.
أمام تحدّي التحرر المزدوج، يبدو أنّ التاريخ بات مجالاً لمعارك الوعي. غير أنّ معركة الوعي التّاريخي ستكون بالغة التكلفة، لأنّ الوثيقة هي ما نكتشفه وليس ما نصنعه، وبأنّ عملية الاعتبار لا تسمح للمؤرخ الشمولاني أن ينطّ بين المقدمات من دون رقابة. لكل حقل معرفي منطق ينظم _ تقييماً وتقويماً_ استدلالته، وللتاريخ أيضاً منطقه، ومنطق التّاريخ يأبى أن يُختزل في الرواية أو الاعتبار الموجّه توتاليتاريّا.
يُطلب التّاريخ في سياقاته كلها، وحقائقه كلها، يُطلب في أسفار ومصنّفات، ويتحمّل المؤرخ مسؤوليته كلها، هذا إن كان مؤرخاً، ولأنّ التاريخ علم خطير جدّاً فعلينا أن نحترمه جدّاً، ولا نلوّح به تلويح الأعشى، ونقمشه قمشة حاطب ليل، ولا نسرد ما علّمتنا إياه التوتاليتارية على قرع النشيد الوطني، بل في التاريخ وفي التاريخ فقط نكتشف نزعة التّحرّر، حين نملك أن نختلف قدر ما يفرضه حقّ الاختلاف. إنّ هناك الكثير من الأساطير المؤسس للتوتاليتارية، ودور العلم هنا تحرري بامتياز.
أعود إلى تجربتنا مع التّاريخ، فلقد كان تقليداً عندنا أن نمارس أقصى الاختلاف، بل نكاد نكون الأمّة التي تخلّت عن كلّ أساليب الديماغوجية التوتاليتارية، لا تربية وطنية، ولا كشافة، ولا حتى تجنيد إجباري؛ كل هذا تراجع. نحن أمة غير قابلة للترويض. بلى، توجد الانتهازيات، والوصوليات والرداءة، وهي نعرفها، لا نخلط بينها وبين النبل في آتون الشمولية المتغوّلة، أجل، يوجد كل هذا في السياسة والعلاقات العامة، ولكن لا توجد آليات لترويض الضمير والعقل.
ولهذا السّبب كنا دائما نتجنّب أن نتغنّى بتاريخنا المجيد، ولا نصبّ أساطيرنا على العالم، ولم نفكّر حتى في إنتاج ملاحم حقيقية عن تاريخنا القديم وغير المنقطع في وحدته، لأنّنا واثقون من تاريخنا، من أنفسنا، واثقون من المستقبل على الرغم من كل المقالب والإرتهانات والمتغيرات والمغامرات والحسابات، بحدسنا التاريخي، نستطيع أن نحيا دون طقوس أنانية، نناضل في صمت، لا نريد اعترافاً بمجدنا التاريخي، نتطلع للمستقبل الذي تخشاه الأمم الفارغة، المستقبل الذي لم نكتب تاريخه ولو بلغة الأساطير؛ لهذا السبب كنت على وشك أن أكفر بالتاريخ منذ أصبح ديناً وأساطير، التاريخ الوحيد الذي نراهن عليه اليوم، هو تاريخ المستقبل، وهناك وجب على الوعي أن ينطلق خارج كل أشكال الطقوس التوتاليتارية والنّازية في تمجيد الأنا ظالمة أو مظلومة.
ومع ذلك، تساعدني خرائف العقل العربي، على تحديد فصول تصحيح التّاريخ، وضبط مكامن المغالطة في لعبة الإخبار، ومكان هذه المعركة هي حقل العلم لا حقل البروباغاندا، إنّ التسلية الوحيدة التي يمتعنا بها فعل الرّواية بلا رواء، هو أنّها فرجة تمكننا من تشخيص وضعية “الدّماغ” في الممارسة العقلية العربية. ففي كل مفصل من مفاصل السردية التوتاليتارية نملك مقداراً من الدحض المنهجي الذي نضنّ به عن غير المحطّات المتنقلّة، بل نحتفظ به لأوان استنزاف اللاّمعقول قبل أن ينبري المعقول.
يُختبر تحرر الكائن في سردياته التاريخية، في مرونته، ومستوى استعداده للخلاف.. نحن في حاجة إلى أن نكتب تاريخنا بضمير علمي لا بنزعة نازية.
كاتب من المغرب