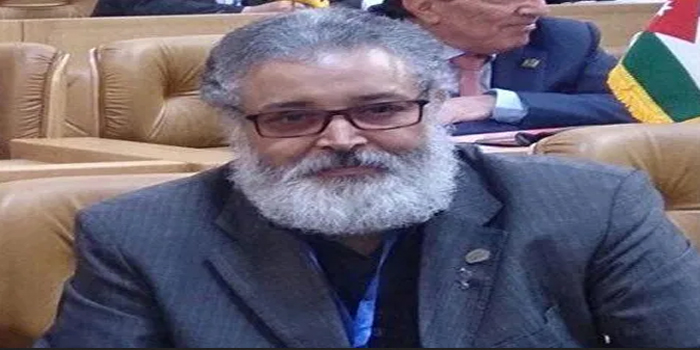.. والشيء بالشيء يذكر
يبدو أنّ العالم يعيش تحوّلاً في تموضعه من الوجود والحقيقة، وثمة أكثر من وسيلة لتحقيق هذا التحوّل، تأتي في مقدّمتها التقاليد الجديدة للبحث والخطاب التّربوي. ليس المستهدف هنا هو الأفكار والحقائق، بل المستهدف هو التفكير نفسه، وملكة تلقّي وابتكار الرّمزي.. معركة الوعي والدماغ والعلامة. وفي مثل هذا الوضع ستنطلق حركة نضالية تدعو للتسوية بين وعي النخبة ووعي الجمهور، وهذه حقيقة وجب الإقرار بها، إنّ الجمهور والنخبة تقاربا في رؤية الأشياء، وهذا حتماً ليس معطىً من معطيات مجتمع المعرفة، بل هو نتيجة توحيد استراتيجيا التّلقّي.
إنّ التقاليد المتبعة اليوم على صعيد الأبحاث وأيضاً في النظام التربوي، تعزز من انهيار القدرات الفائقة للعقل، لمصلحة إمكانات دنيا قد يتم فيها الاستغناء عن الدّماغ، والاكتفاء بأوّليات ردّ الشّرط حيث مكانها النخاع الشوكي.
دعني أنقل ما أراه من جدل بين من يرون أنفسهم نخبة الرأي، مثالين فقط خلال اليومين «الفارطين»:
– يستجمع قدراته الذهنية ليردّ على خصمه على الهواء، ثم يقول: يقول آنشتاين«كل فعل له رد فعل مساوٍ له في المقدار معاكس له في الاتجاه». نفهم هنا أنّنا نعتمد الإحالة إلى الفيزياء لنضمن صكّ مرور لأفكارنا في طبق من مغالطة حجة سلطة العلم، والمشكلة هنا هي أنّ قائل هذه العبارة ليس آنشتاين وإنما هي عبارة عن قانون نيوتن الثالث في الميكانيكا الكلاسيكية التي شكّلت «النسبية» الآنشتاينية انقلاباً عليها. دع عنك الفيزياء.
وبغضّ الطرف عن الخطأ الأخير، فإنّ خطأ آخر في المضمون، فالقائل يعتقد أنّ هذه قاعدة شاملة وثابتة، بينما هي قاعدة لا تصلح إلاّ في إطار الفيزياء الكلاسيكية، الأجسام الظاهرة، الميكرو- فيزياء، وليس لها مكان في الميكروفيزياء، ففي هذا المجال لا يمكنك أن تتنبّأ بشيء، لأنّ ردّ الفعل ليس بالضرورة بالمقدار نفسه وفي الاتجاه المعاكس، بل أضيف إلى القول الفيزيائي ضميمة، ألا وهي أنّ فكرة التوازن نفسها ليست سيان بين المجالين.
ويكمن الخطأ الثالث في أنّنا في المجال الاجتماعي، وجب ألا نقيس الحركة فيه والتفاعل بالميكانيكا، وكان أحرى أن تقاس بالتفاعلات الكيميائية، فضلاً عن الفيزياء غير الكلاسيكية؛ فردود الفعل الاجتماعية لا تأتي بالقدر نفسه ولا في الاتجاه المعاكس.
المثال الثاني: يطرح أحدهم العلمانية بديلاً، فيرشقه الثاني متعالماً عليه: العلمانية مفهوم غربي لا يصلح لنا نحن العرب، وإنما وجب أن نطالب بالدولة المدنية. وليست المهزلة هنا.. المهزلة تكمن في الجهل بأن فكرة الدولة المدنية هي جزء من مفهمة العلمانية نفسها، بل إنّ المتعالم يجهل أن فكرة الدولة المدنية إنتاج غربي أيضاً. وفي مثل هذه الحالة سيجد الضال إبستيمولوجياً وأيديولوجياً نفسه في حقل ألغام مما هو جزء من مفهمة الغرب، فلن يستطيع أن ينطق بمفهوم لم يخرج من جبّة الغرب، ونكابر، وبقية القصيد تجدها عند مظفّر.
حتى إن كان هذا النمط في التفكير طاغياً على من سقطوا في سوق النخبة سهواً، إلاّ أننا نخشى من هذه العدوى التي ترقى إلى مستوى الجائحة.
الجهل ينتشر كالوباء، هناك ما يتجاوز فعل التحريف، التحريف للمفاهيم، للجغرافيا، للتاريخ، كأننا نمارس الزيف من دون أن يرانا أحد. ومع أنّ التاريخ كُتب وما تبقّى هو نازية مفرطة لمحق الطبائع والصخور وحقائق التاريخ، فإنّ وباء التجهيل بات يؤثر بدوره في أنماط التفكير، دعهم يعبثون.
ولا نستثني السياسة، فإنّ الجغرافيا السياسية «تتشقلب» من تحت الإقليم والعالم، والجيش الاحتياطي لاستشراف الوهم «يتشقلب» هو الآخر، ويميل حيث يميل سُرى ليل الجغرافيا السياسية، كأنّ لكل منعطف مقالاً، وأن لكل وثبة رأياً، فانهار هيكل المعنى وتهدمت قواعد التفكير، وحيث إن ما رصدناه واستشرفناه بات واضحاً وضوح الجهل في عصرنا، فإنّ عملية الهروب أصبحت هي المخرج الوحيد، ومن هنا وجب التأكيد أنّ العملية النقدية ينبغي ألا تقف عند الأفكار، بل عليها اعتماد طرق الإحصاء والجينيالوجيا، لأنّ الفوضى اليوم تساعد على الهروب، وتمثّل الرأي النقيض للخروج من الحالة المزرية وتعدّ تهرّباً ضريبياً من المحاسبة المعرفية، فالذين نازلناهم معرفياً باتوا يتبنّون متبنياتنا، بل يتلبّسون كل مدعياتك حذو النعل بالنعل.. أنّى يؤفكون.
كاتب من المغرب