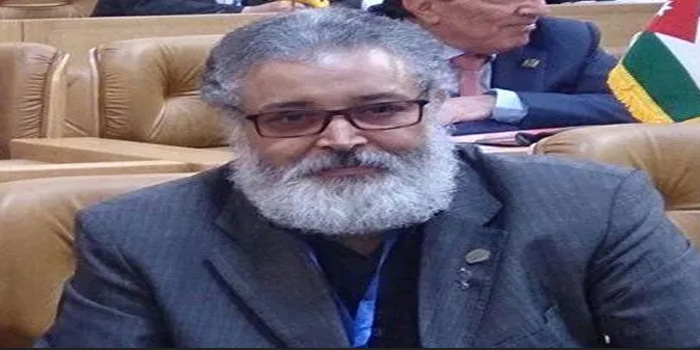من تاريخ العقل إلى عقل التّاريخ.. مستقبل النموذج الكَوْنِي
لطالما حيّرني سؤال العلاقة بين المخّ بشروطه المادية البيولوجية، والعقل كمفهوم ميتافيزيقي. وسيكون الوضع أكثر تعقيداً، حينما نقارب هذا الجدل من زاوية إبستيمولوجية، تبحث عن قضية «السّبق واللُّحوق» بين الواقعة التاريخية والفكرة التي نكوّنها عن الحدث التّاريخي، وهل وجود هذه الفجوة المهملة بقياس الزمن الفيزيائي لها أثر على الفكرة والحقيقة أم أن لا أثر لها؟.. لاسيما وأنّنا نؤرّخ للمديات البعيدة والبطيئة.
إنّ العقل البشري لا زال في أَفْقَهِ ما بلغه يراعه، مديناً لكانط في مثنوية «النومينا والفينومينا» أي سيتكرر ذلك بين الواقعة التاريخية وفهمنا لها، وفي فلسفة الأديان بين الدين (كنومينا) والتدين كظاهرة، وهي مخارج كسولة جداً، تحوّلت إلى موضة، ومن شأن الموضة التلف والتلاشي مع الزمن ومن دون دليل؛ ذلك لأنّ الدين ما أن يصبح ديناً، حتى يكون ظاهرة، فالدين في ذاته ليس شأناً للأمم، ولا يمكن أن يكون في ذاته وهو قاصد.
وفي هذا التمييز استعمال للكانطية في غير محلها ومن دون إعلان مسبق. هذا العقل لا زال عاجزاً وجباناً، لأنّه وفيّ للنموذج، وحينما أتحدّث عن انقهار جماعي داخل النموذج، فهذا لا يعني وضع خريطة للقبائل المعرفية المتنازعة، بل هناك نموذج «كوسمولبوليتكي» غالب على كل مستويات التفكير بما في ذلك شديد التعارض؛ في كل حقبة هناك مشترك يقف عليه الجميع. إنّنا من هذه الحيثية نستطيع أن نعاين مستويات من التناظر في النشاط العقلي والميثولوجي لعصرنا الراهن، فكل عصر تتأثر براهينه وأساطيره بالنموذج الكوني العام.
أذكّر بوجهة نظري حول العلاقة بين البنية والتّاريخ، علاقة لا فكاك عنها مذ عملت منذ سنوات على تقويض الثنائيات، بوصفها سبباً في جمود الفكر وانحرافه. ففي بنية هذه العلاقة وتاريخها أيضاً، نقف على حقيقة مفادها أنّ البنية بما هي متحركة، والحركة وظيفتها، فهي تصنع تاريخها من خلال تخارجاتها الزمنية، وهي بذلك تجعل من التاريخ نفسه حالة رشحان بنيوي، كما أنّ التّاريخ بما هو علم بالماضي، والنظر في الحادثة ووثيقتها، جزء من وظيفته، فهو بذلك يجعل من البنية نفسها حالة رشحان الزّمانية.
وستعمل الزمانية هنا بالمعنى «الهيدغيري» حيث كل زمانية تظهر في كل تخارج من تخارجاتها الثلاثة، على الرغم من أنّ الطاغي على الحدث التاريخي هو التخارج الأوّل: الماضي. لكن تظل تخارجاته الثلاثة كالحاضر والمستقبل حاضرة، أي أنّ المؤرخ وهو يحاول القبض على الحدث، يعكس حالة الوجدان التي تعكس انطباعات الحاضر والمستقبل كما يعكس حالة الفهم التي تبدو متصرّمة.
من هنا اعتبرت أن تغليب منهج على آخر يجعل الاستعمال المخاتل وغير المعلن لباقي المناهج، في وضعية تهريب، وله أثر خطير على الصناعة المعرفية.
إنّ المقاربة الشمولية والتداخلية والدينامية هي الأقل كلفة وخطراً على المعرفة. خذ مثالاً على ذلك كيف أنّ محمد عابد الجابري (فيلسوف مغربي) سلك طريق تفكيك البنيات إجرائياً لتحقيق فهم عميق للعقل العربي، فتحدّث عن بنيات منفصلة ومجردة، في حين أنّ طبيعة البنيات تكمن في تداخلها. ولو أنّه أدرك ما الذي تعنيه البنيات في حقل الكيمياء، لتجنّب هذا الشكل من التجريد اللاّواقعي للبنيات، ذلك لأنّ هوية البنية تكمن في مكوناتها الفاعلة مع بعضها، فالبنية الحقيقية للعقل العربي ليست منشطرة كما ذهب الجابري، إلى بيان وبرهان وعرفان، بل إنها بنية تستدمج كل هذه المكونات؛ فهي مكونات في بنية وليس بنية قائمة في العقل العربي، وحينما يُصار إلى تفكيك بنية ما، فهي تفقد حقيقتها وتصبح شيئاً آخر. في الكيمياء تكتسب البنية هوية كيميائية خاصة هي من يُحدد وظيفتها، لكن حينما نجزّء البنية، فهي لن تعطينا تلك الحقيقة، ويحدث ذلك في المجال الكوانتيكي، فأن يتم عزل مكون عن بنيته، فهذا يغير في ملامحه ووظيفته. وتجريد البنية هو تماماً فعل تدميرها.
وحينما نخطئ البنية سنخطئ تاريخها أيضاً. وكذلك التاريخانية إن شئنا أن نأخذ بها منهجاً يتجاهل البنيات، فإنّها تصبح ضرباً من التسلط الخارج على بنيات يفترض أنها هي من يحدد تاريخانيتها.
إنّنا نختار مناهج ونغلّبها على حساب مناهج أخرى مما يجعل كل نشاطنا الذهني هو عملية تسخير الواقع نفسه في خدمة مناهج بدل العكس؛ ولا مخرج غير العبر- مناهجية، التي لا تجعل التغليب حالة اختيار وميل ورغبة، لأنّ كل هذه العناصر تشتغل ضمن وحدة وتحكمها مصفوفة التَّكَوْنُن في مجال فيزيقي يرخي بشروطه الثقيلة على تجربة الوجود. وسنكون في وضع مريح حين نأخذ بعين الاعتبار البعد الأنطولوجي للكائن ومطلبيته الغائية، هناك فقط ندرك أنّ البنية والتاريخ كلاهما تجلّي لهذه الخبرة الوجودية في شروط فيزيائية وسوسيولوجية قاهرة.
ليس المشكل في أنّ الاختلال في وظائف الدماغ قد تغير خريطة التفكير العقلي، لكن المشكلة تكمن هنا في التزييف الذي يمارسه الدماغ السّويّ نفسه على الواقع. إلى أيّ حدّ يا ترى يمكن القول بأنّ الدماغ أحيانا يكذب على العقل.. وإلى أي حدّ يمكن القول أيضا بأنّ الوظيفية التزييفية هي جزء من طبيعة الأشياء؟
إنّ تقنية التمثل الدماغي للوقائع تفرض أن لا تكون معرفتنا بالواقع إلاّ تاريخية ـ أي سابقة ـ وهذا يناقض الوهم بأنّنا ندرك الواقع في الآن. وفي ظنّي لا توجد معرفة آنية مطلقاً. ليس ثمة إلاّ معرفة قديمة. إنّ المعرفة في حد ذاتها لا تنفكّ عن حقيقتها التّاريخية. إنّ فهم وظيفة الدّماغ وطريقة اشتغاله تؤكّد لنا بأنّ التّاريخ ليس هو الماضي الواقعي فحسب، بل هو الآن الواقعي أيضاً. بل المستقبل حينما نتمثله، وجب أن نتمثّله بعد جملة مسارات لاواعية في الإدراك. أتساءل حول ما إذا كانت معرفتنا بالمستقبل هي في نهاية المطاف ليست إلاّ معرفة تاريخية قديمة؟
أكاد أجزم بأنّ الوعي التّاريخي لا يمكن أن يكتمل من دون وعي فيزيائي؛ فالميكانيكا التاريخية حتى الآن تحشرنا في جمود الوثيقة ومحدودية التّأويل؛ لأنّنا عاجزون عن دراسة الأشياء في ديناميتها؛ لكننا لا زلنا نخطئ كيمياء التّاريخ وأيضاً فيزياءه النووية، حيث ما هو أهمّ اليوم في التّاريخ هو المُهمل، والمتجاهل، وغير المرئي، الذي أهملته الميكانيكا ولكنه هو العنصر الأهم حين ننظر من زاوية كوانتيكية للحدث التّاريخي. فالمحرك التاريخي قد يكون مهملاً وغير مرئي، لأنّنا تعودنا ميكانيكياً وتاريخياً على تقدير المرئي وتشخيص خاطئ لعلاقات القوّة سواء في التاريخ أو الميكانيكا.
إنّ مكر التّاريخ الهيغلي في الحقيقة ما هو إلاّ مكر البنية وعناصرها اللاّمرئية، هو الحقيقة النووية للحدث التاريخي، فالمكر التاريخي يصدمنا بنتائج غير متوقعة، لأنّنا نغفل البعد اللاّواعي للتاريخ، ذلك البعد الذي وجب استدراكه بالتأويل الأنثربولوجي، لما بين السطور، فالتّأويل -تأويل الحدث التاريخي- هو بمثابة تحليل كوانتوم الحدث التاريخي، مما يمكن من تتبع آثار اللاّمرئي والمستبعد وتأثيره على البنيات. المصالحة بين التاريخ والأنثربولوجيا تظلّ أمراً قائماً.
بل سأذهب أبعد من ذلك، وسأعلنها صراحة لأوّل مرّة في تاريخ هذا الجمود المناهجي، بضرورة توسيع مجال الأنثربولوجيا لدراسة، ليس فقط المجتمعات الحديث فحسب كما ذهب مارك أوجي، بل أذهب إلى إخضاع سِيَر النخبة: نخبة العقلانية والاستنارة للدرس الأنثربولوجي وتطبيق مبدأ المشاركة على نشاطاتهم وأفكارهم، بما يعني قراءتها في ضوء نظام القرابة، والعصبية، وتأويل أساطير الاستنارة وأساطير العلم والمثقفين. وأعتقد أنّ هذا سيكون مدخلاً للموجة الرابعة من الحداثة إن شئتم، موجة التجاوز التي يفرضها التطور الجديد الذي يتميز بالنفور والاستهتار إلى حدّ التفاهة، وهو عنوان بتر ذهني من بيئة راهنة وشروطها، استعداداً لمرحلة قادمة نتوقّع صدمتها المفاجئة، حيث تتعانق حقائق الوجود وتتداخل تخومها بشكل يفرض على الفكر تجاوز شروط وحدود وقواعد و«باراديغمات» المرحلة السابقة؛ مصالحة قادمة بين التاريخ والمستقبل، بين الحدث التاريخي والحدث الكوانتيكي بعد إطلاق رصاصة الرحمة على التفكير الميكانيكي للعالم؛ فالعالم القادم يتميّز بدقة عناصره، وسرعة حركته، ووفرة انقلاباته؛ إنه عالم مختلف، عالم كوانتيكي بامتياز، عالم سيفرض شروطاً جديدة على العقل القادم، والأمر لا يتطلّب سوى منعطف مأساوي خاطف، تكون البشرية قد استيقظت من غفلتها الميكانيكية لتدخل عالماً جديداً من التفكير ومن تاريخ العقل، وحينئذ فقط نستطيع أن نقرأ التاريخ من دون تغليب الماضي على المستقبل، أي التاريخ هنا بوصفه تعادل التخارجات الثلاثة التي تحدثنا عنها؛ فلا الماضي يخفي المستقبل ولا الحاضر يمثل الآن بينهما.
إنّ معضلة الفكر الإنساني عموماً اليوم، هو أنّه لا يفكر في الانعتاق الجماعي، بل هو في وضعية طفل في حالة فطام نكد، هو في وضعية من فقد حاسة الشمّ ولا يكاد يحلم سوى بالكوابيس.
كاتب من المغرب