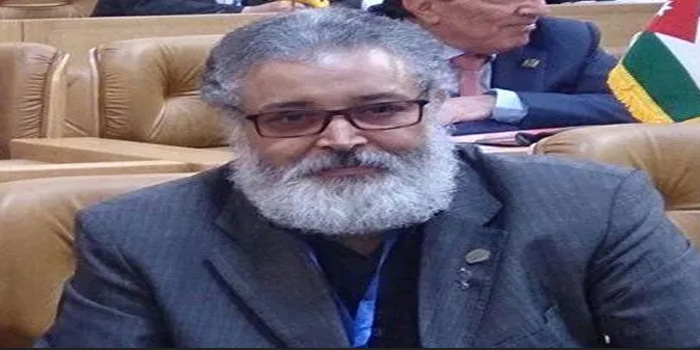سقوط الإخوان المدوي في المغرب.. تصويت عقابي ومؤشر جيوسياسي
لا أقف عند متغير الانتخابات في معادلة الانتقال الديمقراطي، إنّه موسم يُعاد فيه إنتاج العلائق القَبَلِيَّة بامتياز، وهو ما يجعلني مصراً على مقاربة المشهد الانتخابي من وجهة نظر الأنثربولوجيا السياسية، كحقل حيوي يمنح مساحة أوسع لرصد الحقيقة السياسية وعلائقها الثقافية والاجتماعية. إذ إن الأنماط السياسية لها علاقة بالأنماط الثّقافية.
يؤكد موريس دوفيرجي (مفكر فرنسي مختص في القانون الدستوري) الذي كان له حضور رمزي في دستور 1962 المغربي، على هذه الحقيقة، بل اعتبر كل ثقافة قائمة بمثابة مزيج من ثلاث ثقافات تؤسس المشهد السياسي: الثقافة الرعائية، وهي تستند إلى بنية تقليدية غير مركزية بشكل كامل، ووجب الأخذ بعين الاعتبار رأيه في كون الثقافة القديمة لا تندثر نهائياً.. وهناك ثقافة الطّاعة التي ترتبط بالبنية السلطوية المركزية.. بالإضافة إلى ثقافة المشاركة وهي الجانب الموصول بالبنية الديمقراطية.
يصعب مقاربة العملية الانتخابية بعيداُ عن تأثير البنيات السوسيولوجية، وأيضاً التّحلل من الأيديولوجيا، وبما يزيد في تعقيد المشهد، وكأنّنا أمام وضعية تفرض اعتماد إطار تفسيري جديد، شديد التعقيد والتناقض، إطار محكوم بديناميات اجتماعية غير مؤطّرة، ولكنها تنطلق من تعاقدات مفترضة جديدة تنتمي إلى جيل ثورة التواصل الاجتماعي.
يؤكد حقيقة ذلك التداخل بين مختلف مكونات المشهد الاجتماعي، حيث انعكس على دستور 1962 الذي ساهم فيه كبير فقهاء الدستوريين الفرنسيين موريس دوفيرجي.. وهو حتماً ليس كاتب الدستور، بل استشير في قضية لها علاقة بصميم نظريته في النظام شبه الرئاسي، حيث استشاره يومئذ الملك الراحل الحسن الثاني حول شكل النظام الانتخابي بالنسبة لنظام كالمغرب كان يواجه شكلاً من الالتباس، كونه نظاماً تعددياً في ظل مشهد حزبي كان يهيمن عليه آنذاك حزب الاستقلال، الذي كان شبيهاً بحزب الوفد المصري يومها.
غير أنّ دستور 1962 هو نفسه يعكس هذا المزيج، حيث ساهم فيه جيل السلفية الوطنية، مثل المختار السوسي صاحب المعسول، وعبد الله كنون صاحب النبوغ المغربي وآخرون.
كما أسند يومها رئاسة لجنة قراءة الدساتير إلى الفقيه المنوني صاحب مظاهر يقظة المغرب الحديث.
كان من المهم لدى دوفيرجي، هو لفت الانتباه إلى مفارقة الفصل بين السلطات، وهي سمة للنظام الغربي، لكن المفارقة تكمن في تجاهل العلاقة القانونية بين البرلمان والحكومة، فالأغلبية البرلمانية هي نفسها الأغلبية الحكومية، فكيف يمكن الحديث عن فصل بين البرلمان والحكومة، بينما الأغلبية البرلمانية هي التي تدير الحكومة.
فالفصل إذاً ليس بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بل هو في الحقيقة وفي نهاية المطاف فصل بين الأغلبية والأقلية.
لا يمكن قراءة الانتخابات المغربية قياساً إلى التجارب الأخرى، دون استحضار هذه التفاصيل التي تعيدنا إلى اللحظة التأسيسية، إلى الهواجس الأولى، إلى تنظيم المجتمع والمكان والتحوّلات الجوهرية والمجهرية لتاريخ مديد من الممارسة الدّولتية وإدارة الشأن العام وكذا العلاقات الدّولية. ويتعين أيضاً قراءة الدينامية الانتخابية في إطار التحولات التي تعرفها السياسة، حيث تعتبر العملية الانتخابية تعبيراً عن السيادة، ولكن ما هو مفهوم السيادة اليوم؟.. وفي ضوء هذا الإشكال يتعين النظر إلى الانتخابات كدينامية في بيئة متداخلة محلياً وإقليمياً ودولياً، فهناك تأثير متبادل.
في كل عملية انتخابية نكون أمام هذا التكرار الذي يعكس جمود السياسة وجمود البنيات السوسيو- ثقافية التي لها الأثر الكبير على المزاج الانتخابي. فمع كل استحقاق نواجه شكلاً من التصويت الانتخابي.
والحقيقة أنّ التصويت العقابي ليس حالة غريبة أو استثنائية، بل إنّ التصويت لا يكون إلاّ عقابياً، وهو أمر يتكرر في كل التجارب الاستحقاقية بما في ذلك الغرب الديمقراطي.
حين نأخذ بعين الاعتبار حقائق الاجتماع السياسي، يتعين قراءة المشهد من منظور يصعب استيعابه من خارج التناقضات التي يفرضها الاجتماع السياسي وسياقه التاريخي.
عود إلى بدء، فإنّ ما أفرزته الاستحقاقات في المغرب، لم يكن مفاجئاً لأغلب المتابعين لصيرورة الأحداث السياسية. إنّ الانتخابات جرت في وضع مريح، وإن انتابتها بعض الحوادث غير المؤثرة في كرنفال انتخابي يتمازج فيه المغرب المركزي بالهامش، فالهامش يصبح هو المقرر الأكبر في المهرجان الانتخابي.
لقد سقط حزب كبير قاد الحكومة خلال عشرية كاملة، والسقوط كان مدوّياً، أي من 125 مقعد إلى 13 فقط، حيث لم يبلغوا نصاب تشكيل فريق في البرلمان القادم. ومع أنّني من منتقدي هذا الحزب -العدالة والتنمية- طولاً وعرضاً، منذ قيامه حين كتبت يومها: «الفاشلون» وكذلك مقالة «سأرميكم بحذاء» غير أنني لا أجد نفسي في وضعية من يشمت في حزب وقع على مناخيره في آخر الاستحقاقات، لأن نقدي لم يكن كيدياً، بل إنّني أشعر بالشّفقة. هذا بخلاف من كان يراهن على هذا الحزب وربما يتملّق ويستشكل على انتقادنا له.
إنّ سقوط العدالة والتنمية كان متوقّعاً، لأنّهم استندوا في الاستحقاقات السابقة على عناصر متحوّلة، أي على التصويت العقابي والتمكين، والنابعة من شروط لعبة الأمم في تأثيرها غير المباشر على العملية الانتخابية، وأيضاً استناداً على استغلال الرأسمال الرمزي لخطاب ديني افتقدته الأحزاب، ليس الدين هنا كمطلب عقدي للناخب، بل باعتباره ضامناً أخلاقياً، حيث لم يعد هناك من ضامن يُلزم الأحزاب بتنفيذ برامجها التي تبدو واعدة في التمنّيات السياسية.
ويبدو أن المجتمع لم يقع في العزوف السياسي، حيث فاقت المشاركة خمسين بالمئة، ولعل هذا الإقدام على المشاركة في الانتخابات تحركه الرغبة في التصويت العقابي من جهة، وأيضاً دور الأحزاب المنافسة في خلق دينامية في صفوف ناخبيها التقليديين.
سقوط.. وفوز
لا شيء كان مفاجئاً في الانتخابات الأخيرة المُدمجة: مدمجة لأنها شملت البرلماني والمحلي والجهوي، في ظرفية حرجة محكومة بإجراءات كورونا، والدخول المدرسي الذي تمّ تأجيله. ليس الجديد في فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص زعيمه رجل الأعمال عزيز آخنوش، وقد كان يتولى حقائب مهمة في الحكومة السابقة، ولا حتى في السقوط المدوّي لحزب الإخوان الذي كنا نراه كذلك ساقطاً ولا يمكن أن يتفوق على منافسيه في سياق مشحون بتحول مزاج الناخبين وحتمية التصويت العقابي على حزب باع له الوهم طيلة سنوات عشر.. الجديد هو أنّ المشاركة كانت كبيرة تجاوزت الخمسين في المائة، وأنّ الناخب هذه المرة أتى بالليبراليين، ما يعني أنّ فكرة الناخب هي فكرة إشكالية، لأنّ التصويت العقابي هو تقليد يكشف عن جمود لا عن وعي.
آخنوش الذي هزم نظيره سعد الدين العثماني حتى في عقر داره في منطقة سوس، هو رجل أعمال كبير ومستثمر في قطاع الزراعة والبترول. هل سيكون لذلك تأثير في تفعيل المشروع التنموي المقرر لعام 2035 بتفاصيله الواعدة والمحاطة بتحديات مستقبلية؟
التساؤلات اليوم بعد أن فاز آخنوش، ويختار فريقه في الحكومة المقبلة، ما هي خريطة التحالفات الجديدة.. ودور الأحزاب الصغيرة.. والتموضع المحتمل لحزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في المرتبة الثانية.. ما هي ماهية الحكومة وهويتها السياسية.. هل ستكون حكومة تنمية واستثمارات أم حكومة إجهاز على السياسة الاجتماعية؟
الوجه الآخر للحقيقة
لم يكن حزب العدالة والتنمية يتمتّع بعمق اجتماعي إلاّ بفعل التمكين الذي فرضته شروط ما عرف “بالربيع العربي”، لقد كانوا الحزب الاحتياطي للقيام بمهمّة تجنيب المغرب صرعة التآمر الإخواني، في سياق تنفيذ مشروع غراهام فولر لمنح الإخوان فرصة الحكم والتدبير في البلاد العربية. كان حزب “العدالة والتنمية” هو البديل لتأسيس هذه المرحلة.
يعود الفضل في ذلك إلى الدولة وليس إلى الجماعة. إنّ تلويح بنكيران يومها بأن “الربيع العربي “لا زال يتجول وقريب منّا، هو تلويح فاقد للمصداقية، لأنّه خرج من الحكومة وبقي الحزب.
لم يقبل الحزب المذكور المهزوم نتائج الانتخابات،. هم لا يتمتعون بالروح الرياضية، ويعتقد أنّه بالفعل متغلغل في المجتمع المغربي، وهذا هو الوهم الكبير.
لا يستطيع حزب “العدالة والتنمية” أن يحتجّ على الدولة، لأنّه حظي بفرصة تاريخية ما كان ليحظى بها لولا تلك الظروف. فلقد تحول من حزب محدود إلى حزب أغلبي، ثم حصد الكثير من الامتيازات. وأمّا ما يتعلق بالناخب، فهو عنصر متحوّل في صيرورة النظام الانتخابي، إذ لا يمكن التنبّؤ بمزاجه في المستقبل. لكن علاقة الحزب بمزاج الشعب، اتسمت بالجمود، وساهم في ذلك الشعور بالزهو والانتصار والطغيان.
فالناخب هو الآخر له أساليبه وميوله وتقديره لمصالحه ومنسوبه من الانتهازية الشعبية التي يستند إليها التصويت العقابي. لقد تعاقد الحزب المذكور مع الجمهور على جملة الانتظارات والآمال، لكن التذمّر الشعبي من أداء الحزب، ما فتئ يتطوّر بشكل ملحوظ.
يبدو أن المغرب مقبل على مشروع تنموي جديد، ولا مكان للحزب فيه.. وبغضّ النظر عن طبيعة المشروع التنموي الجديد، فإنّ أهميته تكمن في أنّه رسم خريطة طريق تفرض على الأحزاب أن تدخل بتعهدات ومنافسة حول رؤية مشتركة لمشروع تنموي، وليس ببرامج مستقلة من دون ضمانات.
اليوم حزب “العدالة والتنمية” لم يتمكن من الحفاظ حتى على الحد الأدنى الذي يمكنه من موقع مقبول في الترتيب الحزبي، بل إنه عاجز أن يدخل المرحلة الجديدة كمعارضة نافذة، نظراً لعجزه عن تشكيل فريق.
يطرح الكثيرون سؤالاً يبدو منطقياً في الظاهر، لكن يبدو غير دقيق في نظري، فالمشكلة تتعلق بطريقة طرح السؤال. هم يقولون كيف سقط حزب فاز بأغلبية الأصوات بهذا الشكل المأساوي، لكنني أسأل منذ سنوات: كيف أصبح الحزب المذكور حزب أغلبية.. وفي أي شروط وبأي ثمن تحقق ذلك؟
والحقيقة أن ما حصل -وهو تحصيل حاصل- هو سقوط ظلّ مؤجّلاً قبل أن تكتمل إرادة الناخب. لقد تسبب التصويت العقابي وتقنية القاسم الانتخابي في هذا السقوط، ولكن السبب ظلّ مركباً.
العامل الجيوبوليتيكي
إذا نظرنا من زاوية جيوبوليتيكية، فإنّ سقوط حزب ذي مرجعية -إخوانية- هو ظاهرة في السنوات الأخيرة، فشروط “الربيع العربي” التي جاءت بالجماعات المذكورة تنفيذاً لمخطط دولي مشهود، لم تعد ممكنة. إنه سقوط الإخوان في أكثر من بلد وبكيفيات مختلفة- لعل سقوطهم في المغرب كان أقلّ ضوضاء وبأساليب اقتراعية دقيقة – لم يحصل ما من شأنه أن يحول بين حزب” العدالة والتنمية “والمضي على طريقته في الحملات الانتخابية، فثقة الجمهور بهذا الحزب تراجعت إلى الصفر، بل إن كان الناخب المغربي قد زاول التصويت العقابي من قبل، فهو اليوم يعبّر عن إحباط وثأر لا حدود له، لأنّه يشعر بخذلان حزب رفع من سقف الآمال الشعبية، قبل أن يُجهز على السياسات الاجتماعية.
لم يعد الناخب المغربي يخضع لخدعة التّظلّم الذي اعتمدته الحكومة السابقة كاستراتيجيا في خطابها، اعتماداً على مغالطة التظلم. إن ما ينتظر الحزب بعد السقوط المدوي هو جملة الملفات التي تحتوي على خروقات، وتفعيل إجراءات المحاسبة، لأنّ عشر سنوات من التدبير لم تكن خالية من خروقات، وهي ما كان له دور في هذا السقوط المدوّي.
الواقع والمتوقع
في كتابي: سرّاق الله، أنهيته بجملة تؤكد بأنّ الوضع إن استمر هكذا فحتماً سنكون أمام وضعية حرجة تمسّ الفهم الديني للجماعة كما تمس السياسة في هذه الربوع. وهذا ليس استشرافاً فحسب، بل معرفة بالأصول الاجتماعية والثقافية لهذه النحلة التي عاشت هي الأخرى ضحية وهم كبير، وهم أنّها قوة نافذة في المجتمع. لقد أظهرت حصيلة الاستحقاقات المدمجة الأخيرة بأنّ هذا الوهم كان تعبيراً عن ذُهان سيكولوجي جماعي بالتّفوّق.
السؤال الذي ينتظر القادم الجديد، هو ما مدى استعداده واقتداره على إنقاذ الملفات المنهارة في الحكومة السابقة.. وهل يملك أن يستعيد قليلاً من الأمل السياسي للمجتمع.. هل سيثبت بالفعل أنّه يملك خيارات وإمكانات وإرادة مختلفة؟
إنّ التحدّي اليوم يكمن هنا، في مدى قدرة الحكومة القادمة أن تصحح أخطاء الحكومة السابقة.. هذا يتطلّب تحولاً جذرياً ومراجعة دقيقة، لكي لا تكون هناك حكومة تنطح حكومة، من دون تحقيق قيمة مضافة وأرقام عمل مقنعة، وحتى لا يستمر مسلسل الإحباط، ومنح الحزب الخاسر فرصة إعادة إنتاج خطاب ما يطلبه الجمهور، أي بتعبير آخر: إسقاط حزب في الانتخابات ليس نهاية المطاف، بل ثمة تحدّي إسقاطه كمعارضة مفترضة ولو إلى حين.
إنّ انتظارات المجتمع أكبر مما تنتحيه العملية الانتخابية، إنّ الأحزاب هي نفسها نتاج اجتماعي وثقافي للمجتمع بكل تناقضاته. إن انتهازية البورجوازية لا تستطيع أن تفرض شيئاً دون أن تتكامل مع انتهازية البروليتارية الرثة. فالانتهازية حاضرة بقوة حتى أنّه يندر أن يتعفف عنها مكون حزبي أو طيف اجتماعي، إنّنا أمام وضعية صارخة من إعادة الإنتاج، من هنا وجب عقلنة الانتظارات حفاظاً على السواء والصحة النفسية لناخب لا يتنزّه عن استدخال العوامل الاجتماعية والإقتصادية في تدبير علاقته بصناديق الاقتراع والشّأن العام. مطلب الشفافية والتشاركية وكل المبادئ التي باتت حقيقة دستورية وليس خطاباً مفتوحاً على المسامرات السياسوية.
كاتب من المغرب