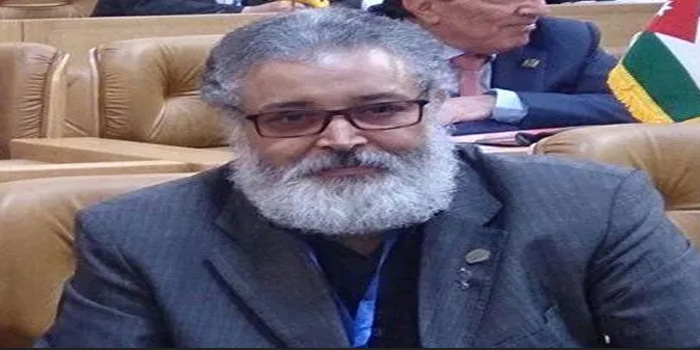بعد الانتخابات الرئاسية في سورية.. ماذا تبقى من كلام؟
لا ينفع الحوار مع مُسمّى “المعارضة السورية”، يحدث أن تتورّط في وجبة نقاش، وتنسى ما تحبل به الذاكرة من تجارب الانسداد التواصلي.
هذه المرّة سيخدعني أحدهم مع أنّني في منتهى الجهوزية واليقظة، حضور لقاء نظمه مركز دراسات حول الانتخابات العربية، كان حظّ معارض سوري في الخارج أن يتناول التجربة الانتخابية في سورية. أعرف مسبقاً أن المركز كان يبحث عن باحث يراعي أصول علم السياسة وحدّ أدنى من الموضوعية. وسيجتهد الباحث وسعه ليظهر تلك الموضوعية التي لطالما اعتبرتها أكذوبة، لاسيما في الفكر السياسي. لم يصبر الباحث على القدر الممكن من التعاقد حول الموضوعية تلك، لتبدأ ماكينة الإساءة: “الرئيس أمبراطور”، “النظام يختار شعبه وليس العكس”، “أوسع صلاحيات للرئيس في كل العالم، لا شيء حقيقي، الأحزاب الجديدة ليست حقيقية، أحزاب الجبهة ليست حقيقية، الانتخابات ليست حقيقية، الانشقاق العسكري هو انخراط في “الثورة”، لا يوجد برنامج لدى أي مرشح”.. أمام هذا المسلسل جاء تدخلي في نوع من النقاش الحميد، بعيداً عن أي شيء يدعو للاستفزاز.
وسيعقب الباحث، ولكنه ازداد إسفافاً، كنت أتحدث برأسي كتعبير عن رفض خرائفه.. كان يتحدث عن عزمي بشارة وآرائه كما لو كان يتحدّث عن مونتسكيو. لما أنهى روايته، طلبت التعقيب مرة أخرى، لم يقبلوا بذريعة أن الوقت انتهى، نعم هكذا تسدل الديمقراطية الستار على آخر عبارة ينطق بها من لم يعجبه تدخلي قائلاً: وإذا لم أستطع أن أقنع إنساناً بكذا وكذا بخصوص سورية، فهذا يعني أن المشكلة تتعلّق بالهوية أو.. أو.. ثم سرعان ما أُسدل الستار على الرطانة الضّد- سورية.
مداخلتي التي ذكرتها وتعقيبي الذي لم يسمحوا أن أقوله هو التالي:
إننا في حقل علم السياسة نسير فوق حقل ألغام. كل قضية هي إشكالية ولها تفاصيل. ولن أتحدث عن تلك التفاصيل، ولكنني سأركّز على أنّ الحديث عن الديمقراطية بلغة الخيال أمر لا ينفع. كلنا نتحدث عن الديمقراطية المستحيلة حين نتحدث عن مبادئها اليونانية الحالمة، تلك التي لم تطبق حتى في اليونان، ولكن سأتحدث عن الديمقراطية اليوم كما هي مطبقة في الغرب، هذه الديمقراطية ممتنعة في العالم الثالث بموجب التقسيم الإمبريالي للنفوذ النيو- كولونيالي. إن كنا سنستبعد هذا العامل الأساسي في فهم الشروط التي تتحكم في صيرورة وتطور السياسة، فلن نصل إلى أي نتيجة. تتحدثون كما لو أن هناك نموذجاً مخملياً للديمقراطية في العالم العربي تأخرت عنه سورية، لكن لكل بلد طريقته في تدبير الانتقال الديمقراطي.
أشهد أنني سألت يوماً في زيارة إحدى وفودنا السيد الرئيس بشار الأسد عن الديمقراطية، فكان الجواب تقريباً: إن الديمقراطية آتية لا محالة، ولكي نصل إلى ديمقراطية صحيحة علينا أن لا ننسى أنّ ركيزتها الأساسية هي العدالة الاجتماعية، إن الديمقراطية بمعنى الحرية المطلقة في غياب عدالة اجتماعية وفي بلد متعدد ومتنوع تعني ما يفيد حرباً أهلية. بهذا المعنى تقريباً كان الرئيس الأسد يحمل تصوراً متقدماً عن الديمقراطية.
لقد استمعت لكل السردية السياسية “للمعارضة”، تلك التي فشلت في إدارة الديمقراطية حتى في حدود ائتلافاتها. لم أجد أي معنى جدّي، إنهم أرادوا السلطة بأي ثمن ولو ببيع سورية في المزاد العلني للناتو.
إذاً، حين نتحدث عن “إمبراطور”، ونمعن في المبالغة، نكون قد انخرطنا في طريق المقاربة المتحيزة والمسيئة. وما لم أستطع قوله هو، أنّ ما تضمنته شروط المرشح ومنها أن لا يكون غائباً عن سورية لمدة عشر سنوات، فهذا طبيعي، فالدساتير متحركة، وسورية في وضع يتطلب وضع معايير للمرشحين.
ما الذي فعلته سورية هنا مناهض للديمقراطية؟ إنّ القول بأن المرشح لم يأت بأي برنامج، استهتار بكل السياق الجيوسياسي لسورية، التي خاضت معركة الانتخابات، وكان من الطبيعي أن يفوز الرئيس الأسد بالانتخابات، لأنه كان مُقنعاً لشعب أدرك دور القيادة في إدارة الأمن القومي لسورية . إنّ أهم برنامج تم تنفيذه، هو جملة الانتصارات التي تحققت، والحفاظ قدر الإمكان على الاستقرار. أما “أن الانشقاقات كانت تدل على موقف ديمقراطي”، فهذه رواية فقدت سحرها القديم بمجرد أن فتح الأمير حمد بن جاسم ملف شراء الذمم، بتعبير آخر، كانت الانشقاقات منذ البداية مدفوعة الثمن، أي خيانة عظمى. تستبعد المعارضة المكتسبات الأساسية في معركة كبرى، مكسب الدولة والسيادة. إن النظام السياسي القائم في سورية لعب دوراً كبيراً له علاقة بالتحولات العالمية القادمة, لأنه ساهم في التحول إلى نظام عالمي جديد، ارتقى بسورية إلى الفاعل الدولي ومحور الصراع العالمي.
إن الحديث عن الديمقراطية في سورية على طريقة ما تسمى “المعارضة”، يعني منح فرصة لتحقيق حلم الرجعية العربية التي تحالفت مع المعارضة من أجل تطور دستوري وديمقراطي، بينما لا توجد دولة ممن قاد الحملة التخريبية ضد سورية تتمتع بوضع دستوري أو ديمقراطي. إن كنا سنتحدث عن السخرية والمفارقة، فهي مفارقة معارضة مسنودة من قوى رجعية لا تتوفر على دساتير ولا تقاليد انتخابية.
حتى وهي تختفي خلف المفهمات/ المبهمات، تبدو ما تسمى المعارضة السورية “حمار” طروادة للناتو والعثملّلي، ما أن تقارعها بالحجّة حتى تذهب مذهباً شعرياً منتهكة علم السياسة. لا أدري ما الذي يجعل المعارض السوري في الخارج يُدمن المبالغة، ويفترض أنه مقنع، وبأنّ ما ينطق عنه بديهيّ، ولكنه عند النقاش يتحوّل إلى حالة طوطمية، مع أنّ الديمقراطية بتعبير خبرائها هي إدارة الحكم بالنّقاش.
لقد لمست أن القيادة السورية متحاورة اليوم أكثر من قادة الائتلافات. يقول المتدخل المذكور بأنهم في حراكهم الأول لم يكونوا يطالبون إلاّ بوضعية تشبه مصر ما قبل “الثورة”، لكنني لم أكن في وضع يسمح لي بأن ألخّص له عشر سنوات من العناد وإرادة التخريب والانقلاب بدأ من رمي جثث الضحايا من فوق جسر نهر العاصي في حماة، وانتهاء بالإرهاب الممنهج.
لا يمكن للديمقراطية أن تتجاهل السياق الجيوسياسي لسورية في إدارة معركة تستهدف الدولة والنسيج الاجتماعي وكيان برمته. إذا لم تؤخذ كل هذه الأمور في الحسبان، فأي حديث عن الديمقراطية حينئذ سيكون ضرباً من التفاهة السياسية.
لا تستطيع ما تسمى “المعارضة “السورية الطوطمية أن تجيب عن سؤال: في أي شرط وفي أي أفق جيوسياسي تنظم سورية انتخاباتها؟ .
إن الانتخابات السورية الأخيرة هي الأكثر ديمقراطية، لأنها عززت الاستقرار والدولة والسيادة ومنحت الفوز لمن قاد أعظم انتصار في الشرق الأوسط. ففي دولة تعيش على إيقاع حرب امتدت عشر سنوات، فإن الانتخابات في وقتها، منحت أملاً جديداً، بأنّ سورية تمارس ديمقراطيتها داخل سيادتها وبعيداً عن التحكم الخارجي.
الذين يعطون دروساً نظرية في الديمقراطية ينسون أن الرئيس بشار الأسد عاش في أهم عواصمها، وهو أدرى بتفاصيلها اليومية.
فرق كبير بين الانتهازية والبراغماتية، هذه الأخيرة هي فلسفة الواقع، هي كيف تستمد الأكسجين من الهواء كالسمكة من دون أن تغادر الماء، حسب تصوير وليام جيمس، وهذا ما يجعل الحديث عن الديمقراطية في سورية قاصر عن استيعاب التعقيدات التي تواجهها سورية بعد عشرية الحرب الكونية على السيادة السورية.
لم تبع القيادة السورية, السيادة السورية مقابل السلطة، لكن المعارضة باعت تاريخ ومستقبل سورية من أجل السلطة، وفي النتيجة سقط قادة الائتلافات الخرافية، وفاز الأسد بأغلبية مريحة من الأصوات، تعبيراً عن الوفاء المتبادل.
وفي الحقيقة أنّ من لم ير ذلك، كان يعاني من عمى الألوان. والحق أنّ قطيعاً من الانتهازيين أدركوا في الوقت بدل الضائع، أنّ سورية الصامدة لن تسقط في الواقع كما تمنوا ذلك في خيالهم، كثيرون غيروا “اللّوك”، غيروا المعجم اللفظي، بينما القيادة السورية ظلت وفية لشعبها ولمعجمها اللفظي ولخيار المقاومة.
كاتب من المغرب العربي