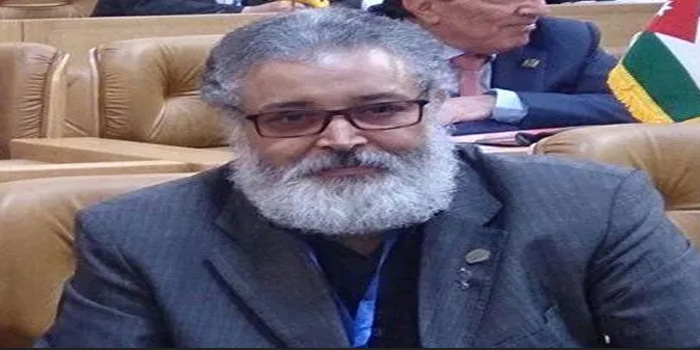في البحث عن الزمن الفلسفي المفقود
تشرين- ادريس هاني:
من الفلسفة علاجاً للحضارة كما ذهب نيتشه إلى الفلسفة كمقاولة، مازلنا عاجزين عن خلق المنعطف.
في يومها العالمي تلحّ الفلسفة أكثر على أن تتصالح مع مهمّتها الأساسية، أعني بها حدس الوجود، تلك التي أرغمها الفيلسوف – الجمل لو شئنا توصيفاً نيتشياً، حمّال قدير صبور لمفاهيم مثقلة، حيث بات العقل على إلحاحيته غير قادر على ضبط المعرفة من حيث هي شعور دافق بالوجود، لا ثقوب ولا انقطاعات تتخللها بسبب الرقابة والضبط اللذين يفرضهما الكاطيغورياس.
تصطف المقولات وتنطلق في مسيرة حاشدة من التكرار، ألا يخجل الفيلسوف بعد كلّ هذا العناء، أن يواصل سير الجمل، وقد تهاوى الكاطيغورياس أمام التدفق الدائم للشعور؟ كما التقنية، فإنّ تدخّل العقل يزيح مساحات أخرى من المعرفة التي لا يمكن أن تضبط، وهي من جنس المحسّ الذي لا يضبط، لطالما استهانوا بدور الشعور الدّافق.
دعاة الحدس والشعور منذ ما قبل سقراط حتى برغسون، هم الجبهة الممانعة التي كشفت عن محدودية العقل كهندسة معرفية، لنقل ضابطة معرفية، كم يا ترى تتساقط من حقائق في سياق هذا الضبط الذي فرضته الما بعد – سقراطية، نحن مدينون لذلك المنعطف، ومازلنا ندفع ضريبة التبسيط، عصر التّفاهة له بداية من هناك، وإن كان تدشين تلك المرحلة عن حسن نيّة، لكن ما إن تغلّب الكاطيغوريات حتى أضعف الشعور الدّافق، وتلاشى تبعاً لذلك إكسير الحياة، برغسونياً ونيتشياً، هناك تكمن مهمة الفلسفة.
قلت الفلسفة؟ لقد كانت يوماً ما أُمّاً للعلوم، قبل أن ندخل عهد العقوق، فلقد استبد العلم باترياركياً، وتجّزّأ كلّ شيء، فتلاشى التركيب، وتبسّطت الرؤية، ادغار موران رائد التركيب أدرك جيداً الدرس النيتشي، إنّه استلهم من نيتشه فكرة التركيب ومن وبرغسون فكرة الحدس، فكرة العقل كلاقط هوائي، كالسؤال البرغسوني عن إحداثية الذّاكرة، والسؤال الموراني عن إحداثية العقل.
قلت استبدّ العلم باترياركياً، لأنّ هندسة المعرفة وتَمَوْقُلها أدخلنا في اقتصاد النذرة المعرفي، وأصبحنا أمام ضغط الموضوعية، وهي واحدة من أشكال السحر الذي ابتهجت به الحداثة، ما هو الموضوعي في العلم؟ ما هو الموضوعي في الفلسفة؟ كل ذلك حسبما ندرك به الفلسفة التي لم يعد لها عند نيتشه محدد نهائي، فهي تارة علم وتارة فنّ. وعليه، هل نحن أمام موضوعيات؟ إنّ الثنائية التي حكمت الهندسة المعرفية في الأزمنة الحديثة، أعادت توزيع الذاتي والموضوعي وفق علاقة المركز والهامش، أزاحت الجروح النرجسية للذّات، كطفيلية على الموضوع؟ لكن من يا ترى ينشئ الموضوع؟ وهل الموضوع يمثل موضوعياً أمام الفاهمة أم إنّه يُعاد إنتاجه في الواهمة؟ الذاتي يحدد مصير الموضوعي، بل جدلهما به يتحقق المعلوم، لدى جاك لا كان ما يفيد تحرير محلّ النزاع، تجاوز الثنائية الجامدة، إنّ التقنية نفسها المعصومة في حساب الموضوعية، تنقل لنا الذّاتي بأمانة موضوعية، هذا القوس في السماء- قوس قزح- بألوان الطيف، هو موضوعياً انعكاسات تتمثلها الذات من خلال جهازها البصري بكل هذا التعقيد، وتداخل الرؤية الصحيحة وأخطاء بارالاكس، الكاميرا تنقل الواقعة كما يراها الإنسان، وليس كما هي في الواقع. هذا التداخل المفارق بين الذاتي والموضوعي، هو ما ينبغي الإمساك به.
زمن الفيزيائي وزمن الفيلسوف، افتقد هذا الأخير معنى الزمن منذ تنكّر لذلك الإحساس الدّافق، هذا الإحساس الحادس للأشياء في تدفقها الأكثر تعقيداً، قبل أن يكون برغسونياً هو وعي نيتشي بالتباس مفهوم الزمن بالنسبة لفاقد الشعور، وهو الزمن في ذاته سُخف.
لما كانت الفلسفة أكثر حكمة، كانت عصية على كل أشكال الاختراق. وبات جليّاً اليوم أن الفلسفة فقدت طراوة السؤال، جمالية الحكمة وعمقها، باتت شكلاً من الإيمائية، فقدت حصانتها، آن الأوان لأن نغيّر هذا العنوان، ساحرة عمياء تحرس معبد المقولة، وتكره التدفق الكبير للشعور والحياة.
في كل يوم من أيام الفلسفة، تفقد هذه الأخيرة شطراً من مهامها، وفي كل عام هناك شيء ما يوحي بأنّ الفلسفة تتنكّر لأصلها، لأنّها باتت صناعة وليست غريزة وإحساساً.
أعود إلى الطفل والفلسفة، فمنذ فقدت الفلسفة فضولها الطفولي، تحوّلت إلى كشكول للتّفاهة، كم هو عمق هذا الوعاء الذي وجب أن نصبّ فيه نفايات المفاهيم الفلسفية الفاقدة للمعنى؟ إن كان الطفل هو صانع مصير الإنسان، ومحدد معالم شخصيته، فإنّ الفيلسوف الحقيقي يبدأ من هناك، وليس من المدرسة. لعلّ أهم مؤشّر على ميلاد الفيلسوف، هو ذلك الإحساس الذي يوحي للطفل منذ يعي ويحفظ تاريخ نزعته، بأنه كائن راشد وسط بيئة حافلة بأرقام من الكائنات، الخاضعة لأسطورة الرشد المكتسب.
لا أستطيع الخوض في مصير الفلسفة في المجال العربي، وكل ما يمكن قوله إنّنا بدأنا نودع جيلاً، ونستقبل جيلاً آخر، أمّا الجيل الأوّل، فقد كدح بما فيه الكفاية لتحقيق مستوى من الإشباع السكولاستيكي، وأمّا الجيل الجديد، فهو مولوع بالملاوغة، تراجعت لغة المشاريع، لقد كانت محاولات كفيلة بتدريب العقل العربي على النّظر، لكن غواية قمع السؤال استبدت بالموقف، إنّ الفلسفة العربية أصابها ذلك الداء العضال، وهو خطاب النهايات، تحولت الفلسفة إلى مرض أو فعل توعيك عقلي بعد أن كانت في نظر نيتشه علاجاً للحضارة.
ماذا في وسع الفلسفة أن تفعل في زمن صعود السّخافة واحتوائها المشهد العربي؟ تلك هي غربة الفيلسوف، إن كان حقّاً محبّاً للحكمة لا زاحفاً على طريقها متموقلاً، جباناً، غير آبه بالشعور.
تأبى الفلسفة التكرار لأنّها معنية بالتدفق اللاّنهائي للمعنى، ففي كل عام وجب أن يدفن الكادحون الفلسفيون رؤوسهم في الرمال، لأنّ كل عام يأتي بأسئلة تتجاهلها المقاولة الفلسفية التي أوقفت هذا الصبيب من المعنى في شريان الشعور، واختزلت الحياة والمعنى في عقل الفلسفة كعقل رواية لا عقل دراية.