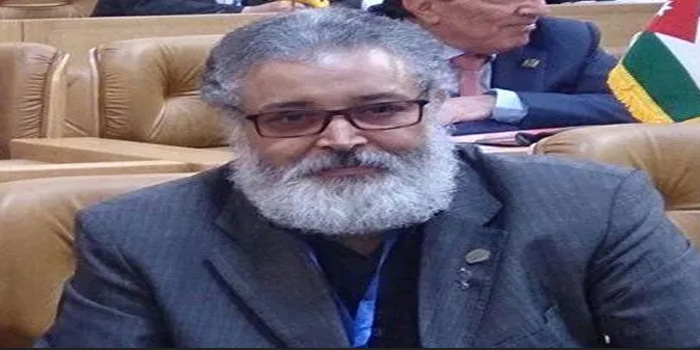ماذا بعد؟ السؤال المُلِحُّ/ المستبعد.. لا مستقبل للكيانات العنصرية
لا أخشى على مستقبل الفلسطينيين ومآل الاحتلال يبدو واضحاً فهو محاصر بانتفاضات لا نهائية وبالمصير المنطقي والحتمي للجغرافيا والتاريخ في المنطقة.
السؤال اليوم بات منطقياً: ماذا بعد؟ ما السيناريوهات؟ هل هناك مقاربة لمستقبل كيان في حالة تفكّك؟ هل فكّر الفلسطينيون في بدائل ما بعد تفكيك الكيان؟ أم إنّنا سنواجه استحقاقات ما بعد الثورة والتحرير كما في سائر تاريخ الأمم؟
الثابت في معادلة العمل الفلسطيني هو انتفاض الأهالي المعنيين، ومن يساندهم ويتضامن بالفعل والاقتدار، بالسياسات والمقاومة القانونية في المحافل الدّولية، في الضغط على الأمم والممالك الغربية لكسر الحصار، للنبلاء والأوفياء للقضية الفلسطينية وليس للدكاكين المتاجرة بالقضية كما يفعل قسم ممن احترف الغوغائية والمزايدة بالزعيق والمسرح البليد الذي ساهم في تراجع الحسّ التضامني بالقضية الفلسطينية لدى شرائح كثيرة من المجتمع.
القدس انتفضت، والفصائل المقاومة موجودة في الميدان، والحركة التضامنية تجتاح العواصم الأوروبية التي تملك القرار.
لا يمكن أن يرتهن نبض الشارع الفلسطيني للوضعية العربية إلى الأبد، وستكون له كلمة الحسم، من هناك ستتغير الحسابات. فلا شكّ أنّ الوضعية العربية لم تكن قط ملائمة لخوض معركة التحرير.
لعل واحدة من المُثل الهاربة أنّ العرب راهنوا على وحدة شاملة كشرط لحل المسألة الفلسطينية، ولكنهم ما ازدادوا إلاّ تجزئة وتنابذاً.
وكان من الضروري أن يتم التعامل بواقعية أكبر مع هذا الموضوع، أي إن قرار المواجهة تتحمله بعض الأقطار العربية وليس كلها.. هذا الإصرار على امتلاك المثال الأقصى، جعل القضية الفلسطينية موضوع استعمال سياسي، مثلما نلاحظ اليوم في بعض البلدان العربية، حيث تأخذ المسألة بعداً انتخابوياً.
إن الوقوف عند هذه الوضعية بتوصيف يجلب الحظّ العاثر، إنما يراد منها تأكيد أنّ مكر التاريخ يدفع باتجاه يجعل المصالح والانتهازية والوصولية نفسها تدفع باتجاه تفجير الموقف.
الشيء الذي لا يستطيع أن يظفر به الاحتلال، هو أن يفرض قدره الخاص على تاريخ محتمل، حينما تنفرج البنيات تاريخياً يصبح كل شيء في خدمة التحرر، وهذا ما يجعل الانتهازية نفسها جزءاً من حركة التاريخ.
لقد كان متوقعاً أن تتهالك القوى الفلسطينية وتزداد تشرذماً، وهي في ذلك لا تفعل سوى أن تعكس الوضعية العربية، فكل طيف في المشهد العربي إلاّ ولفلسطين منه نصيب، ومنذ أوسلو والفصائل الفلسطينية تبحث عن مخرج، حيث فقدت السلطة -التي ولدت ميتة- سلطتها؛ فما تحقق اليوم، هو أنّ الصيغة الأكثر نجاحاً منذ 2018، هو قيام غرفة عمليات مشتركة تضم أهم الأذرع العسكرية للفصائل باستثناء فتح، كان ذلك أهم إنجاز، حيث تعود الفكر التأسيسية إلى عام 2006، التي أسفرت عن وثيقة وفاق وطني نصّت في بندها العاشر على العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
وباتت الجبهة تتألف من 12 جناحاً عسكرياً كلها شاركت في مقاومة الاحتلال وهي:
كتائب الشهيد عز الدين القسام، سرايا القدس، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب المقاومة الوطنية، لواء نضال العامودي، كتائب الأنصار، كتائب المجاهدين، كتائب عبد القادر الحسيني، كتائب الشهيد جهاد جبريل، جيش العاصفة، مجموعات الشهيد أيمن جودة..
ومع تطور أداء المقاومة، وتغير قواعد الاشتباك، تكون القضية الفلسطينية قد قفزت إلى مرحلة جديدة، وحققت قطيعة مع مرحلة سابقة، وهو ما يتطلّب وعياً مختلفاً بناء على الشروط الجديدة.
كل ما يبدو اليوم، هو أنّ المقاومة تتطور من حيث أدائها والبيئة الشعبية الحاضنة وأيضاً البيئة الإقليمية على ما تعانيه من اصطفافات مختلفة، إلاّ أنّ المقاومة تجد اليوم بيئة مختلفة عن السابق، هذا وبينما تتطور المقاومة، نلاحظ تراجعاً في إمكانات الاحتلال، أي إنّ القوة بدأت تفقد قدرتها داخل هذا التعقيد الجيوبوليتيكي والديمغرافي والاجتماعي الذي تعيشه الأراضي المحتلة.
ما يقوم به الشعب الفلسطيني على أكثر من مستوى، هو فعل تاريخي.. والفعل التاريخي هو تناقضي وليس فعلاً صافياً، أي لا ينتظر أن يكون هذا الفعل واعياً فقط، بل هو حصيلة وعي ولاوعي، معقول ولا معقول، وفاء وانتهازية، شجاعة وجبن. وهذا الفعل لا يمكن أن يقوده أحد غير الشعب الفلسطيني بوصفه مضطهداً. لا المحتل ولا أي طرف يملك أن يحدد للشعب الفلسطيني الوسيلة الأفضل، لاسيما بعد أكثر من سبعين عاماً من الالتفاف على حقّ شعب يعاني من أخطر أشكل الآبرتهايد.
فالشعب الفلسطيني غير معني بعقدة الإثم التي تحوّلت إلى مرض دولي.. إنّ العدالة الدولية ومصداقية القانون الدولي منذ عصبة الأمم حتى اليوم تواجه اختباراً في فلسطين، ولن يخفف من هذا الاختبار محاولة تقسيم المسؤولية بين الاحتلال والمعذبين في الأرض، فبالنسبة لهؤلاء المعذبين هناك مسؤولية تاريخية واحدة: الكفاح.
الشيء الأهم اليوم هو أن فلسطين عادت إلى الواجهة، وأمسك أهلها بزمام المبادرة، واهتزت عواصم العالم بحركة تضامنية واحتجاجية، وفرضت على مجلس الأمن حصة من المناقشة، وأدخلت العالم في حرج حقيقي، وهو أنّ شعباً مضطهداً لن يسمح بأن تجرف التحولات الجيوسياسية قضيته العادلة. والشيء الأهم هو خفوت الأصوات التي صدّعتنا خلال عشرية التحرر الزائف الذي ساهم في تدهور الوضعية في فلسطين المحتلة. والشيء الأهم أيضاً، هو التطور الذي شهدته انتفاضة المقدسيين، والتي أظهرت بأنها غير معنية بكل ذلك الإنشاء من التسويات الفاشلة. والأهم اليوم أخيراً هو ابتلاع مرتزقة العشرية السابقة لألسنتهم بعد أن رأوا أنّ صمود الفلسطينيين ما كان ليظهر لو أنّ آراءهم الرجعية هي التي انتصرت، ولا ندري بأي خرطوم سيحللون الوضع الجديد والصمود الجديد؟
قلت إن ثمة سؤال مُلحّ ولكنه مستبعد أو لنقل جزءاً من اللاّمفكّر فيه: ماذا بعد؟
إنّ القناعة باستحالة صمود أي كيان عنصري في وجه التحوّلات الجيوسياسية والحضارية، يقتضي عودا إلى ما قبل التنوير.
فعلى الرغم من كل هذا التعثر الذي واجهته رسالة التنوير وثورة الإنسان الحديث إلاّ أنّه لا رجعة فيها.
فالعنصرية والتمييز مدانة مبدئياً ولا يمكن أن تمحى من سجلّ المواثيق الدولية.. ولد الاحتلال في فلسطين ميتاً لأنه تأسس على نقيض التعاقد الاجتماعي، بل على نقيض حتى الحالة الطبيعية.. حالة مصنعة، هجينة، ممسرحة.
كم من قدرة فائقة، وكم من سياسات مهددة للسلم العالمي ومصداقية القانون الدولي يكلف صمود كيان ينتظر تآكل ذاكرة شعب مضطهد؟
لن يستطيع الاحتلال الحفاظ على كلّ هذه الإمكانات المهولة التي يحرس بها صموده كنشاز، ففي صحافة المحتل اضطراب كبير، وفي كل هزّة يستشعرون خطر النهاية، لقد يئسوا من ذاكرة الفلسطينيين، لأنهم يشاهدون انبعاثاً متجدداً لإرادة التحرر.. لا شيء أكثر ألماً بالنسبة لمحتل من أن يرى ذاكرة الشعوب المضطهدة حيّة. فبعد تلاعب دام عقوداً بالقضية الفلسطينية، من يستطيع إقناع الجيل القادم بإمكانية التسوية بشروط لم تعد مقنعة لفلسطينيي الانتفاضة؟
ليس من باب التمني الحديث عن تفكك الكيان العنصري، وهو الأخطر في العصر الحديث، بل هو منطق الأشياء الذي لا يقارب بحساب الأسلحة الفتاكة التي تراكمت لمواجهة الأنظمة العربية، بينما لم يعد هناك تهديد حقيقي من هذه الأنظمة. وهذا ما نقرؤه من زاويتين:
الأولى، وهي أنّ كيان الآبرتهايد ببريتوريا كان يملك ترسانة من السلاح لم تنفعه مع الانتفاض المستمرّ للشعب الإفريقي. إن انتفاضة الشعوب تحيد أفتك الأسلحة.
الثاني، كما ذكرنا مراراً، فإنّ الأسلحة الفتاكة تصطدم ببارديم جديد للحرب كالذي تناوله الجنرال ربرت سميث، حيث انتهى إلى تأكيد لا جدوى القوة في زمن الحرب الموجهة بل المفروضة داخل الناس. ما قيمة الترسانة النووية أمام انتفاضات الشعوب. بل إنّ القوة هنا تفقد قوتها بتعبير برتراند بادي.
تفكك الكيان حتمية تاريخية، كانت قضية حدس تاريخي لكنها اليوم باتت قضية برهانية. ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ وهو سؤال مفتوح، ولكنه سيصبح سؤالاً أكثر إلحاحاً في الفترة القريبة القادمة..
كاتب من المغرب