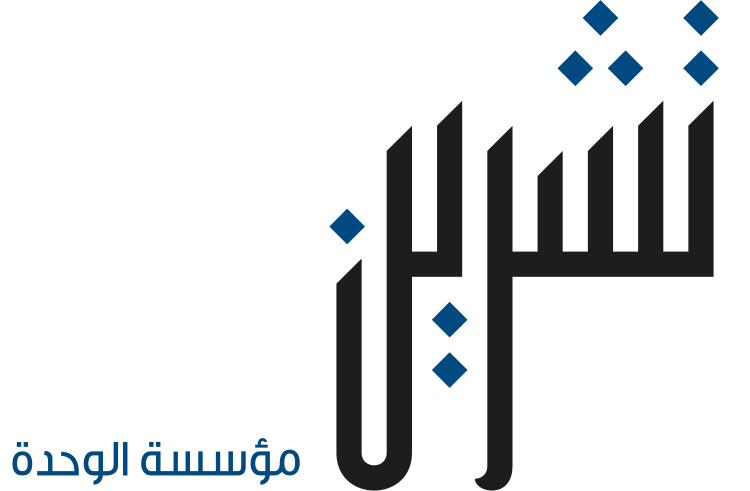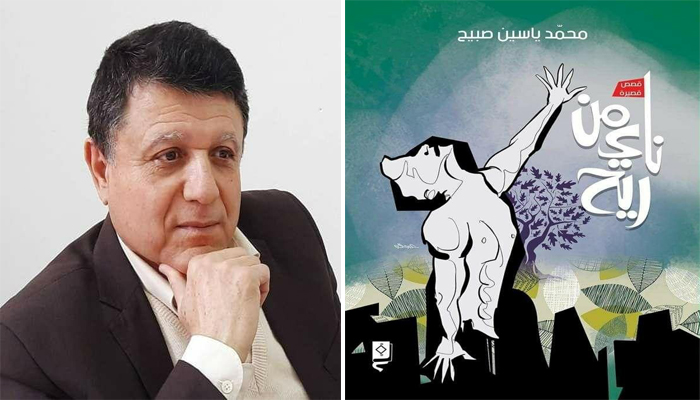ناي محمد ياسين صبيح.. للبحر الذي يغسل ذنوب الهاربين من أقبية حناجرهم
راوية زاهر
«ناي من ريح» مجموعة قصصية للكاتب والناقد الدكتور محمد ياسين صبيح الصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع- القاهرة، وقد سبقها الكثير من الإنجازات الأدبية، المتنوعة بين شعرٍ وقصة قصيرة جداً، حاملاً لواء الفن – الأخير- بكلِّ تجلياته حيث خصّهُ بكتبٍ نقدية وإبداعية، ومنها: “نافذة من جدار، جرأة للفرح..”.. أضف لإشرافه على مجموعات قصصية مشتركة وتحكيمها من قبيل: “أشرعة من ضوء” الذي يصدره ضمن سلسلة الكتاب الدوري، والكثير من النتاجات التي يضيق المكان عن ذكرها..
والمجموعة التي بين أيدينا (ناي من ريح) تحملُ بين صفحات مجلدها 18 قصة قصيرة، تدور في رحاب الأمكنة من بحرٍ وشوارع وأسواق ومقابر، وأمام عتبة الكتاب وهي العنوان سنتوقف، (ناي من ريح).. فمع رحلةِ الناي الحزين، يبدأ الكاتب رحلة مجموعته، ذاك القصب الباكي على أصله، المُجتث من حقول القصب، لينوح على شرفات الأرصفة، والشوارع وسور المنشية، ويعزفُ وجعَ الخيبةِ من حبٍّ وراء جدار، ويستنفرُّ من ثقوبِها الفرحَ الهارب من عشوائيةٍ تشكيليةٍ عبثية تنتهي بمأساة، وتبوحُ في آخر صرخاتها بوجه الريح أمام فجيعة والدٍ نسيّ أن يصنع باباً ليحرس به قبرَ ابنه المغدور الذي سطا المتنفذون على ضريحه بقوة العربدة، (فلكلِّ شيءٍ باب حتى الموت).. هنا جلسَ يبحثُ عن مترين فقط من الأرض يكونان بابَه النهائي يوماً ما، ولابدَّ أنهما برفقة نايٍّ تئنُّ حزناً وحنيناً في حضرة الريح.
لم يعتمد الكاتب على تقديم الشخصية ضمن مساحة جغرافية في زمانٍ معين، بل كانت الشخصيات هي القائمة بالفعل، وما تفيض من دلالات وإسقاطات من علوها المكاني وارتباطه بالحدث.. إذ نوّعَ القاصُ في وصفه لشخصياته من الداخل والخارج، فقصة (اللوحة الأخيرة) تتوزعُ فيها الأبعادُ النفسية مع شعورِ الوحدة القاتل، فجاء الوصفُ الخارجي كوصفه لذاك المخلوق الجانبي الذي يجلسُ القرفصاء بثيابٍ رثة، والداخلي لذلك الرجل، وهو يتنمرُّ على الرسام، بمنولوجٍ داخلي يرافقهُ صراعٌ متنامٍ للنفس البشرية، لينتهي الحدث برحلة خلاص أخيرة تمثلت بالخروج من قوقعة الزمان والمكان وتلك الأفكار حبيسة المرسم والعقل.. كما ركّز الكاتبُ على اللون والحركة في قصصه، وذلك في عرضه عملية مزج الألوان ضمن اللوحات التشكيلية، فالاخضرار في المراعي، واليباس وما يعكسه من انكساراتٍ نفسية تنالُ الشخصيات، والحركة المتمثلة في جلسة القرفصاء، وحركة أرجل المارة وألوان أحذيتهم، وما تعكسهُ من فهمٍ للطباع والرغبات والأسرار التي تحملها رؤوسهم، وتشي بها أحذيتهم.. وكان لوحدة الأثر والانطباع الذي تركتُه كُّل قصةٍ على حدة حضور مميز، وهذا ما قد ينتظره المتلقي ليحدث عندهُ متعةً ينشدها على الصعيد العقلي والنفسي.
المكان في المجموعة ذو بعدٍ نفسي، ولكلَّ مكانٍ بعده الخاص، فتارةً كان رمزاً للخيبة المتكدسة، فخلف سور المنشية كان البطلُ ينتظرُ وجه حبيبةٍ لتعود بعد أن أزالت البلدية بسطةَ كتبه بحجة التعدي على المكان، وقد رميت في حاويات القمامة، فصارتْ مجلدات بائع الكتب في لحظة يأس كوجوهٍ تاريخية هاربةً منسية على صفحةِ ماء، بعد أن رماها طعماً لأسماك الخيبة والحزن، تندبُ التاريخ والحب والزمان وأبطال القصص والروايات.
فيما كانت لغة الكاتب شاعرية وظفت في مجالٍ توصيفيّ للأمكنة والشخصيات، وتصاعدت حالة الرومانسية في لوحات الشهوة والجمال في كثيرٍ من مواقع حضور المرأة المشتهاة.. وكان لهذه اللغةِ دور في كسر لغة السرد، وانفتاحه على لغة المجاز والاستعارة والتورية ذات الكثافة الشعرية العالية، وتأسيس للحظة تنويرية.. كما ظهرت النظرة الفلسفية العميقة في بوح القاص عن تاريخ الماء.. والقبو الذي يقبعُ فيه البطلُ ليسَ من منظوره قبواً يُنظرُ إليه من دنو أو ظلام، بل كان ملاذاً عميقاً للأعلى، يعشقه بعمقه العالي؛ إذ يغوصُ بصاحبه متدلياً في باطنِ الذهن نحو العلياء والسمو الفكري.. وكان الظهور المُكثف للصور جلياً بجمالية واضحة واستكشافٍ لأشياء خفية، وما قد تثيرهُ هذه الصور من الجمال والفرادة والدهشة، ومن جميل استعاراته المكنية (أكل المطرُ كلَّ حاجيات البيت/ نتسلقُ أشجارَ الرغبة/ يخطو نحو فحولته الهاربة/سيقان الحقول..) وغيرها. وبدا جلياً استخدام التشبيه بأنواعه: البليغ، والبليغ الإضافي، والتام.. (رحم حلم مرير)، (يجتازُ البطلُ الطريق الجبلي كثعبان)، مع جلاء استخدامه للرمز وما يحمله من إيحاءٍ وإضمار، كالكلب في قصة (مراعي الليل)، فهو رمز الوفاء الذي أبى أن يخون صاحبه في رحله انهزامه الأخيرة هارباً من وجع خيانة رجولته له أمام محبوبةٍ من مرمر.. وحالة التطير التي سبقت زفافه؛ إذ وشت له الطبيعة بجنونها أن شيئاً خفيّاً موجعاً ينتظره، فهو الراعي الذي أبعد نايَه عنه حتى لا تنقل زفراته وأوجاعه للعابرين. تكاملت عناصر القص في المجموعة، بصنعتها المتقنة في اختيار الموضوع ومعالجته، مع جودة الأسلوب الذي يزيد من طلاوته رهافةٍ تدلُّ على حساسيةٍ عالية.. وقد مالتْ أغلب القصص إلى الطبقة الفقيرة والبسيطة وغاصتْ عميقاً في واقعها الذي يتقاسمه البؤس والحزن، والأمراض الاجتماعية المتمثلة بسطوة المتنفذين، وفرض ما يريدون بقوة العربدة.