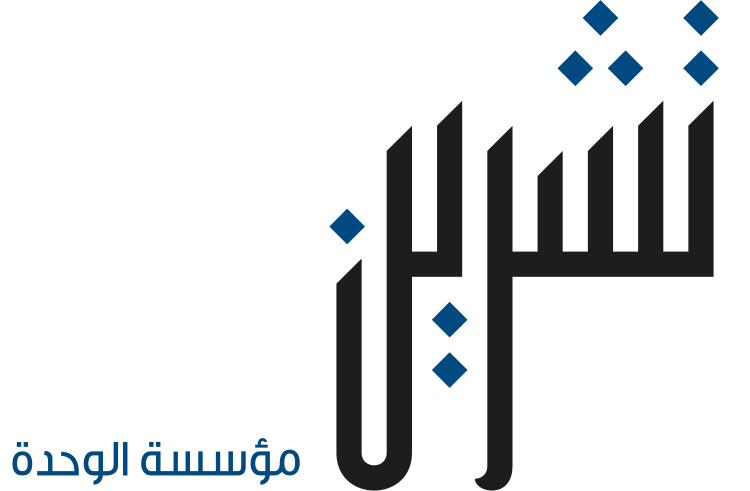التفكير في الفلسفة بالفلسفة
تشرين- إدريس هاني:
– لا يمكن استقالة العقل عن السؤال الأنطولوجي؟ ليس من حيث إنّ هذا السؤال هو أوّل مباحثها الذي يصدمنا، بل من حيث هو خبرة. تسبق المقولات مدرسانياً إدراكنا للوجود، بينما شعورنا بالوجود أساسي، وهو أوّل ما يستصرخنا، نختبر تكوين العقل وتطوره بمدى اقترابه من السؤال الأنطولوجي.. كل شيء ينهار حينما تُصبح الفلسفة إبستيمولوجيا منزوعة الشعور.
– الأحداث الكبرى التي لا تؤثر في القول الفلسفي، تمنحنا دليلاً إضافياً على ضحالة وجودنا، انحطاط فكرنا، صمود أصنام المقولات المتهالكة، تراجع قوى النّفس وملكاتها. إنّ الجوهر العقلي عاجز عن تحقيق حركته التّاريخية، يتعين أن يمتد شعورنا وحدسنا الصدرائي أو البرغسوني معاً، ليصبح حدساً بالحركة الجوهرية، وبذاكرة الجوهر ومآلاته الممكنة.. إنّ الشعور وحده يجعلنا نتألّم من هذا الجمود، حيث إنّ أوّل إدراك للوجود هو شعورنا به.
-هل ما بين أيدينا من أدوات معرفية، يكفي لفهم العالم الذي يبدو في حالة تحوّل مستمر؟ أم إنّ جمود مقولاتنا نابع من إيمان راسخ بالعود الأبدي في مجال الطبيعة؟ إذا كان العالم غير محدود، والفكر غير محدود، فما طبيعة العوائق الإبستيمولوجية التي تسببها محدودية مفاهيمنا عن العالم والعقل؟ كلّ معضلة إبستيمولوجية تترك أثراً بالغاً على صعيد الإدراك الأنطولوجي، حيث إنّ المعضلة قد لا تكون في نسيان الوجود، إلاّ إذا أدركنا أنّه تلك المساحة من الجهل التي تتسع يوماً بعد يوم بسبب محدودية المفاهيم، التي أردنا أن نجعل منها حكماً وإطاراً لفهم ما كان وما سيكون، هل أدركنا حجم الخراب في الذهن البشري؟
– كيف لحقبة محدودة من تاريخنا العقلي، جعلنا منها نهاية العقل، ثم نقع في نوبة زهو بروميثيوسي، ونجعل من ذلك أفضل الأنظمة العقلية الممكنة؟ إنّ فرض الجمود على العقل، وقمع الشّعر، من المؤكد أن ينتهي بنسيان الوجود. غير أنّ العودة إلى تتبع آثار المنسي منه كمعضلة فيزيولوجية في الأصل الجيو-فلسفي التقليدي، لن تكون هي المخرج الأكثر حيوية، حتى لو كان همنا في الذّوق الماقبل- سُقراطي. لماذا لم تستعن الفلسفة بالأنثربولوجية للوقوف على تعددية الأصول والأصوات في المكتوب والمحكي، لإعادة تركيب وتفكير الوجود؟
– إنّ واحداً من أخطر أمراض الفكر المعاصر، هو إخضاع الفلسفة لجدل المركز والهامش، ذات التقسيم الامبريالي للأمم: غرب ينتج المفاهيم وجنوب يستهلك، مع أنّ الغرب في مبتدأ نهضته فكّر من داخل همومه الاجتماعية، ومع أنّ الفلسفة لا مركز لها، لأنّها بطبيعتها ثورية تحررية، لقد فرضت الامبريالية جموداً على الفلسفة من داخل المجال الغربي العام، جمود يليه قمع ورقابة، وهو الغرب ذاته الذي فرض علينا مُفَكَّرَه ولا مُفَكَّره، تعطيل الهامش عن تحقيق ثورته الفكرية التّاريخية، من خلال التحكم في الإنتاج والنظام التربوي، علماً أنّ المركز حين يفسد، يكون الهامش مصدر إعادة بعث وتجديد المركز، اليوم بات الهامش رهينة للمركز وليس بيئته التي تمدّه بالقوة والاستمرارية، معضلة الاحتكار في إنتاج وتوزيع الثروة المادية والرمزية.. إن المركز يعيد إنتاج نفسه بشروطه الامبريالية، وبات تعطيل الهامش شرطاً لبقاء مركز غير متصالح مع الإمكان البشري المفتوح.
– ما عدد المقولات التي يتعين على العقل أن يستغني عنها في عملية التفكير المفتوح؟ ما عدد المقولات الجديدة التي يحتاجها العقل؟ إنّ ما يبدو مسلّمات كالوعائين الزماني والمكاني اللذين وضعهما كانط إطاراً لإمكانية المعرفة، يجعلنا في الوقت نفسه ندرك مُفارقة عقل تكمن قيمته في أنّه إمكانية وقوة، أمّا العقل بالفعل فهو لا يستغني عن الإطار، المفارقة تكمن في أنّه هو صانع الإطار وهو المؤطّر به في الوقت نفسه، يستنتج العقل من العالم صورة انتزاعية عن الزمان والمكان، ثم يفرضهما إطاراً لا تقوم أي معرفة إلاّ بهما، بما فيهما الزمان والمكان، ما هو الإطار الزماني والمكاني اللذين بهما تحققت المعرفة الأولى بالزمان والمكان نفسيهما؟ إذاً هما حدسيان لا واسطة في إدراكهما، هل الزمان والمكان واقعيان، لهما حقيقة موضوعية؟ كيف عُرض الزمان والمكان على الفاهمة أول مرة؟
– لا يمكن بناء رؤية فلسفية حاسمة من خلال موقف فلسفي معين، ليس هناك تاريخ خطّي للفلسفة، بل هي حدث مقعّر وتاريخ منقطع، فيه استلهامات من كلّ الحقب، ذهاب وإياب، تحليل وتفكيك، لا تتحقق الرؤية الكاملة إلاّ من خلال موقف عبر-مناهجي، هذا الموقف الأخير غير إحصائي أو ترجيحي، بل هو مواكب ومتحرك، ناظر فيما هو ثابت من المناهج وما هو محتمل وما هو مفترض، ما هو موجود بالفعل وما هو موجود بالقوة، في إطار هذا الموقف ينفتح العقل وتتسع مداركه، لأنها معنية بالمنتهى الأنطولوجي، لا يوجد تنزيل وتطبيق في العبر -مناهجية، بل هناك تكامل وتركيب وجدل، حتى المناهج الحمقاء هي صوت مشروع في هذا الملتقى التركيبي الخلاّق.
– الخطر الذي يداهم الفلسفة، هو حشرها في لعبة التنزيل، طريقة التكوين التي تشبه أي تكوين، التربية على كل شيء في غياب الملكة، الفلسفة كالشعر وسائر الفنون، هي موهبة، والباقي تهذيب، يتعين أن تستعيد الفلسفة أبويتها لسائر العلوم، لكن شريطة أن تتحرر أوّلاً من سجن نمطها القديم، من خوفها المزمن من السُّؤال الذي هو أصل مشروعيتها التّاريخية، أن تُعانق الشّعر لأنّه حضن الحياة، والشعور، والجمال، وموطن الإدراك الحدسي بلا واسطة في الثبوت والإثبات، لقد تثاقلت الفلسفة بأوزار مقولاتها، وبُرهانيتها التي مسّتها عدوى المفارقة، بتقسيماتها التي فرضت تخوماً نحن اليوم أكثر شعوراً بخطلها .
– تضخّمت اللغة التي كان من المفترض أن تكون هي مأوى الوجود «هيدغر»، لكّنها باتت تشوّش على الإدراك الماتع للوجود، مذ تراجع الشعر، واستبدت المقولات، بل باتت مأوى للماهيات الشاردة المتجاهلة للوجود. علينا أن نبحث عن إيتيمولوجيا الوجود في هذا الصمت المهيب، الذي يسكن خارج اللغة، المتاهة، في تلك المساحة التي مازال يخشاها سماسرة القاطيقورياس، لأنّها تُهدد المصالح التي تتعاقد حولها المعرفة، وتنشئ منها سجناً باراديغمياً، تحيطه بالألفة والوهم وسلطة الاكتفاء.
كاتب من المغرب