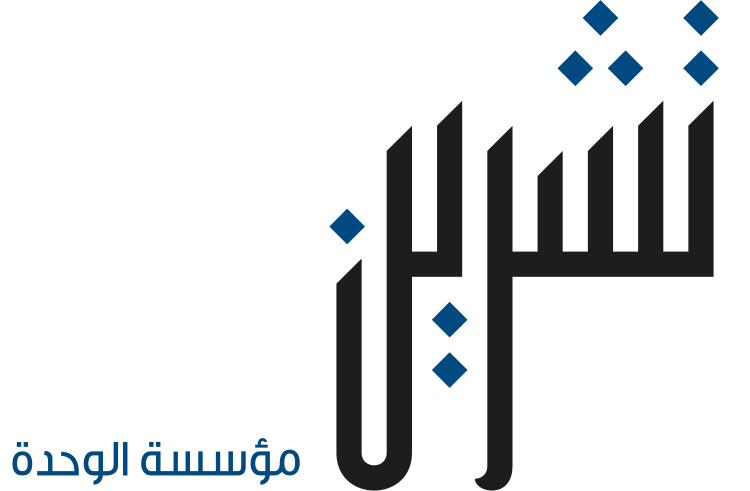حدس الوجود وبؤس المفاهيم.. هل من مخرج تاريخي للمأساة البشرية؟
ادريس هاني:
اللاّقياسية إذاً، يتساءل فرانسوا جوليان: هل يمكن لمفهوم كهذا أن يغير حياتنا؟ سأترك السؤال والموضوع إياه لمناسبة أخرى، ولكن سأقف عند دور المفهوم، بشكل عام، في تغيير حياة الإنسان والجماعات والأمم والحضارات. هذا الكائن المعرفي الذي يبدو بمنزلة دينامو التفكير في النّفس وفي العالم، كائن يقدّم نفسه خارج منطق المواضعة، بل يقدم نفسه ككائن سابق للإنسان، ولا يتوقف مصيره على رغبته. فهو يؤثث العالم ككل الأشياء. لو كنا في عصر الكلام لتساءلنا: هل المفهوم قديم أم محدث؟ مخلوق أم منتوج اللّوغوس؟
ربّما يفيدنا نظام الخطاب في فهم وجه من وجوه متعددة يثيرها وجود المفهوم في حياتنا الخاصة والعامة، وهذا أيضاً يضعنا في حيرة من أمرنا، حيث لا طريق لفهم المفهوم إلّا بالمفهوم. «نظام الخطاب» يفيدنا في رسم خريطة لتاريخ الفكر «وتوالد المفاهيم»، كما أنّ فكرة النموذج تجري هنا على صناعة المفاهيم، حيث وإن حاولنا عدّ المفاهيم وإبداعها هو شأن للصناعة الفلسفية كما ذهب دولوز، لكن من يملك أنّ يتخطّى «حجاب الجهل» ويحدّثنا عن مفهوم غير مسبوق بمفاهيم.. من يا ترى يحدثنا عن المفهوم الذي لا مفهوم له «مفهوم المفهوم».. هل كان الإنسان يوماً ولم يكن المفهوم؟
إنّ الطريق المختصر لتغيير حياتنا هو البحث عن مفهوم جدير بتحقيق هذا التحوّل، لا تبحث عن رافعة أخرى غير المفاهيم. فبالمفاهيم نخوض الحروب، وبها نصنع السّلام، قدر الكائن أن يولد داخل بيئة المفهوم، ويتوقف مصيره على مصير المفهوم.
نسعى للتميز بوجودنا الخاص، لأننا مؤطرون بمفهوم الكائن ذي الخصائص الكذائية، إنّنا قبل أن نولد داخل استحقاق مفهوم الماهية الإنسانية ودور البيئة السوسيوثقافية والتاريخية، كنا نحدس أنّنا في بيئة تتميز بقوانينها، وأيضاً بكائن خاصيته أن يتمرد على تلك القوانين، ومن هنا تناقضات الاجتماع البشري.
نعيش اليوم مرحلة متقلبة من حياتنا البشرية على هذا الكوكب، نحن على الرغم من الاختلافات التي تتسم بها الحساسيات والاتجاهات والمصالح والطبقات والأمم والدول، كلنا نعيش على مخرجات مفاهيم في وضعية مأساوية. إنّنا ضحايا مفاهيم لم نستطع التّخلّص منها، ولا نجد سبيلاً لتجاوزها، لأنّ الدماغ نفسه تكيّف على الاشتغال داخل حدودها.
لا شكّ في أنّنا مختلفون، لكننا في العمق أسرى لشروط مفهومية تعوق انطلاق الحدس وتحرره. المشكلة في العالم ليست في الاختلاف، فهذا الاختلاف ظاهري جدّاً، لأنّ الاشتراك حاصل في جوهر التموقع من المعرفة، من لعبة المسافات، من تديير التناقضات، إنّهم يتخالفون داخل اشتراكهم.
لسنا أمام أزمة مفاهيم، بل أزمة كائن استغرقته المفاهيم الفاسدة، أزمة تحرر، لكنه ليس فقط تحرر سياسي، فهذا مظهر واحد من مظاهر أخرى، أعني التحرر من أسر المفاهيم، امتلاك مفاتيح الانعتاق من ديكتاتورية المفهوم. إنّ البشرية حين تدخل عالم المفهوم تضيع المفاتيح، وتصبح أسيرة للمفاهيم. المفهوم حين يفقد فاعليته ويتحول إلى أحناط، فهو لا يتحلل في الطبيعة الذهنية، بل يبقى هيكله قائماً حتى مع افتقاد ديناميته. ومن هنا نرى في دينامية المفهوم علامة على حيويته وإنتاجيته، فالمفاهيم التي تفقد ديناميتها هي أحناط مفاهيم.
أن تجدد حياتك وتحقق الميلاد الثاني، هذا يتوقف على اكتشاف المفهوم الأكثر دينامية، والذي يمنحك القدرة على التغيير. وهكذا، ما زلت أرى الواقعين في وادي الجمود، المحرومين من نعمة الحركة الجوهرية، يفوضون مهمة تدبير شؤونهم لمفاهيم ذات وظيفة تاريخية، يتشبثون بها حتى آخر رمق، يسلكون كالقطيع من دون أن يثيرهم ما هو مدهش ولا قياسي في عالم، هو مجرى تداولي لا تنقضي علاماته.
ما المخرج إذاً من هذا الحصر.. كيف تتحرر البشرية المرتكنة إلى أنماط القطيع، والمشدودة من عناقها بأنشوطات المفاهيم.. كيف نخرج من خدعة حرب المفاهيم إلى مساءلتها في الصميم؟
أعود إلى عنوان الفكرة التي لطالما عالجتها، طمعاً في أن تكون مفتاحاً لتحرير الذهن البشري، وهي فكرة لطالما أيضاً تعرّضت للاختلاس غير الوفي للتقاليد العلمية، أعني بها «حدس الوجود» وهذه الفكرة لها صلة بالموقف الثوري من الميتافيزقا، من لعبة المفهومات نفسها، من هذا الخداع السكولاري للفلسفة، فلا يمكن أن يتم اختلاس فكرة ثورية بأدوات تفكير جبان وإيمائية المسرح الصّامت.
لا شيء قبل المفهوم سوى حدس الوجود، الوجود سابق للمفهوم، والوجود نفسه يتوقف على المفهوم، وقبل انكشاف المفهوم هناك حدس الوجود، هناك صورته المحايثة للوجود، من حيث هو هو. فالوجود هو صورته، ولا إثنينية في المقام. لقد تكاثرت المفاهيم نتيجة الجهل وليس العلم. لأنّ نهاية المفاهيم هي إعداد الذهن لحدس ما لا مفهوم له.
وحينما نقول إنّ المفاهيم هي نتاج وحاجة الجهل، فلأنّ الإنسان كلما تقدّم في التاريخ وفي الاجتماع، تكاثرت أسئلته، وأمام تدفق هذه الأسئلة ومضاعفات الجهل بمخارجها، تولد المفاهيم، لتكون واسطة في تحقيق البرهان.
فلو كان الإنسان يعيش وحده بمعزل عن الاجتماع، هل كان في حاجة إلى استظهار الكاطيغورياس؟ هل كان في حاجة أن يوقف سيل حدسه ليتواضع على مفاهيم وقواعد تفكير مشتركة ليتحقق بها استقرار الوعي الجمعي بالظاهرات؟ هل يحتاج إلى براهين؟ ولأجل من سيقدم هذه البراهين إن كان حدسه يعفيه من هذا العناء؟
عد إذاً إلى حدسك، سترى العالم فيك منطويّاً، ستدرك مهزلة العقل البشري حينما تراجع الحدس لصالح لعبة المفهمات، التي هي محاصرة الوجود، مدخل للاغتراب، لأنّ الحدس يمنحك قدرة فهم الوجود قبل غواية المفهومات. فالخلاص في إعادة ربط المفاهيم بوظيفتها السوسيو-معرفية، وربطها بحدس الوجود.
لا شيء يعكر صفو الحدس وجديته، لكن البراهين وهي حاجة للاجتماع أكثر مما هي حاجة لمن يباشر العالم بحدسه، هي سمة تراجيدية للاجتماع البشري. فالحقيقة لا تمرّ مرور الكرام في مسالك البرهان، نظراً لأنّ الاجتماع البشري أضعفَ سائر الملكات التي يتقوم بها المراد الجدّي للمعرفة. فعوائق المعرفة من داخل لعبة البرهان تنامت بشكل كبير كالفطريات حتى أصابت الذّهن بعوائق معرفية، فلا هو استطاع أن يبتكر نظرية في العلم حاسمة، نظرية الكلّ، ولا هو أمكنه العودة إلى حدسه الأول. فالكائن الذي يبدو في حالة مسخ تاريخي، افتقد الطريق الموضوعي للمعرفة؟ ستسأل: وما هي الموضوعية؟ إنها بالطبع ليست ذلك المفهوم الحيزبون الذي يسكن في كنانيش الهواة، وتتراقص حولها أشباح التبسيط الذي قادتنا إليه المفاهيم المنزوعة الحدس، بل الموضوعية تعني كلّ هذا التعقيد الذي لا يصار إلى فهمه، أعني لا يفيدنا القول باستيعاب أن العالم شديد التعقيد، وهي دعوة نيتشية التقطها الجيل المتأخر من الفلاسفة الذين جلدتهم النازية في الحرب العالمية الثانية، بل إنّ التركيب لا يصار إليه بالبرهان، بل أولاً وقبل كل شيء وجب احتواؤه بالحدس. وأمّا نيتشه فقد اهتدى لذلك من خلال شذراته التي يصعب تصنيفها: هل هي من الفلسفة أم من الشعر؟ والحقيقة أنّها بَنَتْ معظم تصوراتها على هذا الحدس الشعري الذي به – وبه فقط – يمكن استئناف العودة إلى منبع الحكمة الخالدة، ولا شيء في مفاهيمنا خالداً سوى ما كان حدساً للوجود.