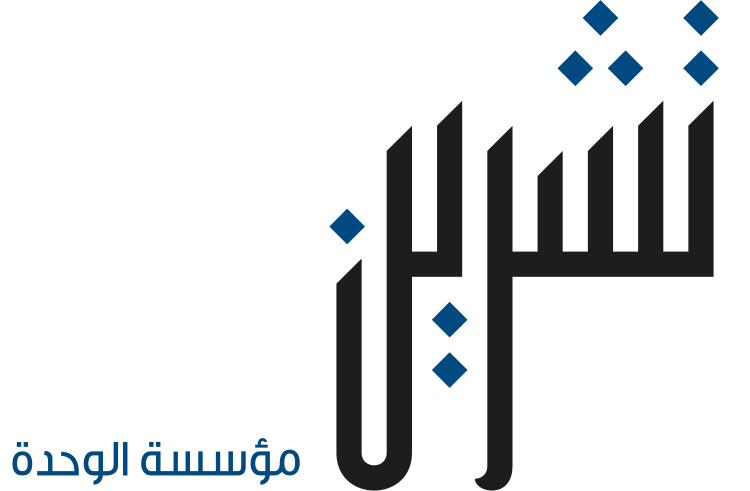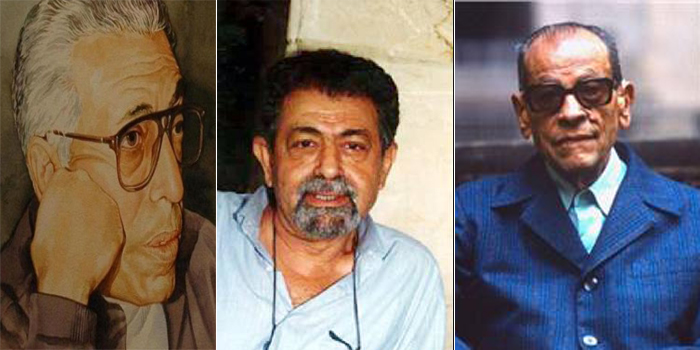تاريخُ ناس القاع والروايةُ كتاريخٍ موازٍ لما سجّله «المُنتصرون»
تشرين- علي الرّاعي:
ليس ثمة تاريخٌ حقيقيٌّ كُتب في هذا الكون؛ وكل ما دوّن على أنه تاريخ؛ ليس سوى وجهات نظر وآراء.. سواء كُتب ذلك في الكتب التي تزعم أنها التاريخ، أم جاء ذلك في سياق عملٍ إبداعيّ، أي كان نوعاً من أنواع الإبداع، أو ما جاء في الملاحم والأساطير والأديان، وأظنّ الأخيرة أخطرها لما تُحيط قصصها التاريخية من قداسة تظنُّ أن لا باطل يأتيها لا من خلف ولا من قدّام!! وهذا ينطبق على ما كتب في الزمن السحيق، وعلى ما كُتب في الأمس!! ومع ذلك ثمة الكثير ممن يرى أن الرواية كفنٍ إبداعيٍّ سردي، هي نزهة خلال الأمكنة، وبأزمنة مختلفة.. نزهة تفترض رجوعاً هادئاً، وخلال هذه النزهة، وثمة الكثيرون ممن عوّل على هذه النزهة، أن تقدّمِ تاريخاً موازياً لتاريخٍ صنعه «المنتصرون» على هواهم.. لكن هنا تاريخ إبداعي، يقدّمُ أحداثه التاريخية جمالياً، وكأنه يكافئُ بذلك ما يمكن أن نطلق عليهم «المهزومين» الذين لم يتسنَ لذواكرهم من يُسجلها، أو يؤرخ ليومياتهم، ومن هنا كان اتجاه الكتابة الروائية على وجه الخصوص، صوب ناس القاع، لتكون ذاكرة المغلوبين ككتابة موازية لتاريخ ناس يملكون السطوة لصناعة تاريخهم كما يشتهون، ويتشهّون، ومن هنا تأتي الكتابة لتحمي الذاكرة، ولكي تؤسس للحاضر، فالذاكرة هي كلمات الحاضر التي يقوم « المنتصرون» بمحاولة محوها.
مستودع الأسرار
ومن هنا أيضاً يأتي الكثير من السرد الروائي كتاريخٍ موازٍ، وإذا أردنا أن نعدد، فسنحصل على عددٍ غير قليل من هذا السرد، وربما يأتي في مقدمته ما دونه الروائي عبد الرحمن منيف في (مدن الملح) التي وجد الكثير من النقاد في هذه السلسلة الروائية تجسيراً للقطيعة بين التاريخ المهزوم والتاريخ الذي لم يكتب بعد، وهي حين تلتقط التاريخ من أفواه المهمشين والمضطهدين فإنها تكتب التاريخ الحقيقي.. فالواقع لا يتسع إلا نادراً لحقيقة روائية هي أقرب إلى الخيال أو المثال، تُكتب الروايات لأننا بحاجة إلى أن نتذكر ما هو مطلوب منا، ونتذكر أننا ننشد عالماً مختلفاً.. فالرواية تعلمنا مقدار التكلفة الباهظة التي علينا دفعها، كي نحقق شيئاً مما ندعو إليه أو نفكر فيه، أحياناً..!!
والتاريخ ليس غاية في ذاته، وهذا ما نجده في روايات هاني الراهب، أو حنا مينة، وإنما الغاية تكمن في ترهينه وإعادة قراءته – كما يرى أحد النقاد- وإذا كان الأمر كذلك، فهل السبب هو الشك في هذا التاريخ، ومن ثم الرواية هنا، تأريخ لما خفي، أو تاريخ سري، وربما مغيّب؟! دائماً كان التاريخ المدوّن أو الرسمي، هو ما يوافق أيديولوجيا وعقيدة الأقوى، بل ثمة تناقضات هائلة في التاريخ ذاته ، بين دولة وأخرى، البعض على سبيل المثال يرى أن غزو العثمانيين لدول العالم العربي «فتحٌ» مع أن التاريخ لم يشهد أسوأ من احتلال كهذا..لاشك في أن التاريخ يحتوي على الكثير من الخفايا والجوانب المغيبة.. ومن هنا الحاجة إلى التاريخ تكمن فيه بالذات، ما يقودنا إليه، لدينا أسئلة لانحصل عن إجاباتها إلا هناك، إنه مستودع الأسرار، تعيدنا إشكالات الحاضر إلى التاريخ، لنبحث فيه وبهدفٍ محدد، هناك قد نجد المعنى لما يحدث اليوم على سبيل المثال، وقد يستجرنا إلى أبعد وأعمق، وهذا لا يعني العثور على إجابات، بل قد نعود من دونها، إن عملية الاستقصاء والبحث، تكافئنا بالكشف عن أشياء تمس حياتنا من جميع جوانبها.. تلك التي نتخبط في الخوض فيها.
وفي هذا المعنى كانت تجربة عبد الرحمن منيف.. فهذا الروائي القادم من الصحراء العربية، والذي حمل إلى الرواية العربية تجربة أخرى تكمل الحكاية التي بدأها نجيب محفوظ في ثلاثيته.. محفوظ روى البداية عبر ثورة 1919المصرية، ومنيف روى شبح النهاية الذي نبت نفطاً في الصحراء، محولاً المدن والصحارى ووادي العيون إلى وادياً للموت.
استطالات مع التاريخ الروائي السوري
هاني الراهب في معظم رواياته ، ولاسيما روايته «ورسمت خطاً في الرمال» يذهب في هذا الاتجاه أيضاً، و« رسمت خطاً في الرمال» تُضيء اليوم بـ« تأريخها» على الكثير مما تُمارسه الأنظمة، وغدر الرمال: «في الصحراء.. لا تمتزج حبتا رملٍ أبداً، ملايين السنين تبقى الحبة بجوار الحبة، وتبقيان حبتين، هكذا روح ابن الصحراء، دائماً وحدها، زجّها بين ملايين الأرواح تبقى وحيدة، التراب يمتزج، نحن نظلُّ رملاً..!»
هل كان هاني الراهب يقرأ تحولات العرب بعد أكثر من عقدٍ على عبور الكون ألفيته الثالثة، وذلك في رائعته الروائية روايته المذكورة بهذه «النبوءة» التشاؤمية قرأ الراهب حال العرب اليوم، أو حقيقة التفكير العربي الذي يكون «الربع الخالي» مرجعيته، فلن يأتي منه غير «السموم» إذا ما هبت الرياح..!
لذا من العبث الادّعاء أننا لا نكتب بدعوة من التاريخ، فهو الذي يدفعنا إلى التفكير في المستقبل، ونعمل حسابنا له، ومن ثم لا أتصور رواية تذهب إلى التاريخ من دون حمولة من الحاضر.. لأن البشرية، وكما يرى الكثيرون هي بأَجمعها ضحيّة التزوير المتعمّد للتاريخ وضحية التّلفيق والحذف والشطب وضحية أديان وميثولوجيا مشكوك في مصداقيّتها، وضحيّة أحداث لم تحدث أصلاً، وضحيّة شخصيات وهمية ليس لها أي أثرٍ مادي في الوجود، وضحيّة أشخاص أقلّ من عاديين كتبوا أشياء ضحلة وغريبة لا تستقيم مع العقل السليم، ومارسوا أفعالاً شائنة ومخزية ربما من بعض تسمياتهم: «السلف الصالح».. وها نحن نحصد اليوم ما أنتجته أفكارهم المنحرفة والشاذة.
من جهتي، أرى في كلِّ هذه الاستطالات مع التاريخ بأنواعه الشعبي، التراثي، الملحمي، والديني، أظن أن ذلك ينشدُ أمرين: الأول تحريك الذاكرة التراثية، أو إعطاء حياة ما لهذا التراث، وفي المقابل، منح العمل الإبداعي شيئاً من السكون، أو العزلة في وجه حداثة لا تلوي على سكون، مع ذلك يأتي هذا العمل بكامل مفردات الحداثة والمعاصرة، أي الشغل على موضوع الذاكرة ليس مبعثه الحنين، ولو كان الأمر كذلك لكان اشتغل المبدع هنا على مسألة التلوين – كما فعل كتّاب المنتصرين- كما لاينشدُ التسجيلية أو الوثائقية، ولاعودة ماضٍ ما، وإنما الإغواء في كلِّ ذلك قراءة التاريخ بصورةٍ مغايرة، ولذلك هو يُناكف هذا التاريخ، وربما يُناوشه، ويقدّم موقفاً ووجهة نظر مختلفة عن السائد الذي فُرض بسطوة المنتصر!!