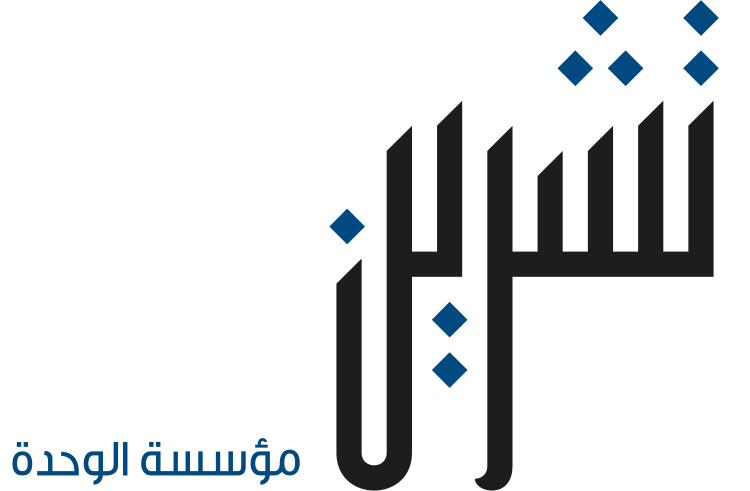الحرب.. وأشياء أخرى
في زمن الحرب يعلو صوت الرصاص فوق كل صوت.. ولأن «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» تكون الشعوب مطالبة بالتراص خلف دولتها وجيشها والتحلي بالصبر والتضحية في سبيل تحقيق النصر المنشود.
هذا الكلام ليس صحيحاً دائماً، فبعض الدول والأنظمة تخوض الحروب في محاولة لتصدير أزماتها الداخلية، هذا ما اشتهرت به “دولة” العصابات الصهيونية في فلسطين، وما تفعله مملكة آل سعود في اليمن.
وهناك دول أخرى تشن الحروب بهدف نهب الشعوب والسيطرة على مقدراتها. وفي كل الحالات تُستغل حماسة الجماهير وتعبئتها لحرف أنظارها عن أزماتها وعن الأهداف الحقيقية لهذه الحروب.
خلف غبار المعارك تغيب التغيرات التي تصيب المجتمعات نتيجة ما تتركه هذه الحروب، من أزمات اقتصادية واجتماعية تنال من استقرار الشعوب ونمط معيشتها.
في زمن الحرب يحل الخوف محل الطمأنينة، وتتعزز غريزة الخلاص الفردي بكل ما فيها من أنانية. يترك فقدان الأحبة والمعيلين تشوهات اجتماعية واقتصادية فتتفاقم حالات الفقر، والتفكك الأسري، واللجوء، ويصبح الأمن الاجتماعي والاقتصادي في حكم المفقود. يصبح الإنسان أكثر ميلاً للسلبية وتوجيه التهم، وأكثر ميلاً لتصديق الشائعات وترويجها.
تبذل الحكومات الكثير من الجهد لحل الأزمات، لكن الحروب الكبرى غالباً ما تترافق بأزمات كبرى، إذا أضفنا لها الدعاية المضادة التي يشنها العدو فإن كل حدث بسيط قابل للتحول إلى أزمة. وما على العدو سوى استغلال ذبابه الإلكتروني لنشر شائعة، مثل «فقدان الخبز» أو «ارتفاع أسعار النفط» لترى طوابير المواطنين تتجمع أمام الأفران ومحطات الوقود، ويمكن أن تحدث مواجهات بين المواطنين أنفسهم، أو بين المواطنين وأجهزة الأمن، وتنتشر الصور على مواقع التواصل، وتصبح المواجهات خبراً جديداً، فتُكرس كل الجهود لحل أزمة ليست موجودة أصلاً.
في الحرب الوطنية العظمى التي تخوضها أمتنا اليوم ضد الاستعمار، يكرس هذا الاستعمار آلته الإعلامية المهولة للتسلل إلى ثقافة مجتمعاتنا. ويحاول الاستيلاء على الثوابت الثقافية وتسخيرها لخدمته. في ربيع الصهاينة استولى الاستعمار على الدين، والبنية الاجتماعية العشائرية، وأصبح عملاء الاستعمار وإرهابيوه ممثلين لهذه الثوابت الثقافية، وهرع الليبراليون المتضررون من الأنظمة الوطنية، وفلول اليسار المحبط لمنح هؤلاء العملاء صفة الثورية، لنجد أنفسنا أمام «ثورات» يقودها خبراء وضباط أميركيون وصهاينة وآخرون تابعون لحلف “ناتو”.
يبرز هنا دور الثقافة والمثقفين. فهم الجدار الناري الذي يحمي المجتمعات من تسلل ثقافة العدو، ويصنع ثقافة التصدي لهذا العدو.
لكن شريحة واسعة من مثقفينا كانوا غارقين في نرجسية «الفيلسوف الملك» المعارض لكل ما هو سائد، ويرون أنهم من طينة نادرة مثالية تتيح لهم الارتقاء فوق الواقع ومحاكمته من عليائهم. تركوا الباب مفتوحاً لاجتياح ثقافي لا يقل خطورة عن الاجتياح العسكري. ووجد بعضهم في تاريخه المعارض لأنظمة الحكم في بلده سلعة يمكن بيعها، فاستسهلوا الارتزاق بتاريخهم وثقافتهم حتى وقعوا في فخ خيانة أوطانهم والتآمر عليها. كان من الصعب على هؤلاء العودة إلى حضن أوطانهم، فهاموا على وجوههم في عواصم العدو، وتحولوا إلى معاول لهدم الوطن الذي ناضلوا يوماً في سبيله، لينتهوا منتحرين أو منسيين في بقاع من العالم لا تعرف عنهم شيئاً.
تبرز في هذا المجال تجربة المثقفين المصريين، فقد انحازوا بسرعة إلى جانب دولتهم وجيشهم في مواجهة المخطط الإخواني المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية. بعيداً عن التهريج الإعلامي وبعض المبالغات للمتزلفين، ظهرت أعمال درامية منحازة تماماً لوجهة نظر الدولة المصرية ومصلحة الوطن. استطاعت أعمال مثل «الاختيار» و«القاهرة- كابول» و«هجمة مرتدة» تعبئة الشارع في مواجهة مخططات الإخوان الإجرامية، ونشاطات منظمات الأنجزة التي تنخر البنيان الاجتماعي والسياسي.
هذا الاستثناء المصري قابلته ميوعة وضبابية في الإبداع وخلط في المفاهيم في بقية الدول التي استهدفها ربيع الصهاينة. فظهرت أعمال درامية تخلط بين المعارضة الوطنية المرتبطة بالوطن، والمعارضة الخارجية المرتبطة بالعدو. فالدراما السورية التي كانت تتصدر الدراما العربية قبل الحرب، تراجعت إلى خانة مكرورة ومنفصلة عن الواقع تتناول البيئة الشامية.. حتى الأعمال التي حاولت تناول الأزمة، ساوت في معظمها بين الوطني والخائن، وساقت من الواقع تبريرات للخروج عن الوطن ومنه، وروجت لنفسها من موقع الحياد، وكأن من صنعوها لم يسمعوا ما قاله دانتي من أن الدرك الأسفل في الجحيم مخصص لأولئك الذين يختارون الحياد في وجه الظلم.. هل يعقل أن صنّاع الدراما لم يجدوا في 10 سنوات من الحرب أبطالاً على مثال «أحمد المنسي» و«محمد المبروك» بطلي مسلسل الاختيار؟.. المقاربة نفسها يمكن أن نسقطها على الدراما في الأردن، ولبنان، والعراق، وتونس.
يبقى السؤال: لماذا هرب معظم المثقفين العرب من ساحة المواجهة مع العدو؟
تاريخياً حاول المثقفون العرب مواجهة العدو (المحتل/الاستعمار) لكنهم تقمصوا الموقع السياسي والثقافي لهذا العدو. ويوماً بعد يوم أخذوا بالابتعاد عن جوهر المعركة الحقيقي، بصفتها معركة تحرر تقوم على طرد العدو وفك الارتباط مع بناه السياسية والثقافية والاقتصادية. وعلى قرع طبول منظمات الأنجزة تحول هذا المثقف إلى طرح قضايا المستعمر، كحقوق المرأة والطفل والأقليات والتعددية الثقافية، مُغرقاً في تبعيته واستسلامه للمحددات الثقافية التي صاغها العدو.
لم يكن الدور الوطني التعبوي للمثقف مطلوباً في تاريخنا الحديث كما هو مطلوب اليوم، فالعدو أقوى من أي وقت مضى ووسائله أكثر تعقيداً وتشعباً. ما زال المثقفون مطالبين بمواجهة العدو كل يوم، والنزول إلى الشارع كل يوم، وتشكيل محور مقاومة ثقافي يحارب أفراده كما يحارب الجنود على الجبهة. أن يطرح المثقفون عن كواهلهم نرجسيتهم، ومواقفهم من أنظمة الحكم، والالتجاء إلى الوطن، لأن الوطن أكبر من الجميع، وسوف يبقى بعد رحيل الجميع ليكتب تاريخ من خانوا ومن صمدوا.
………………………..
(منظمات الأنجزة هي منظمات المجتمع المدني اسمها NGOs وفي اللغة العربية يشار إليها بمنظمات الأنجزة).
كاتب من الأردن