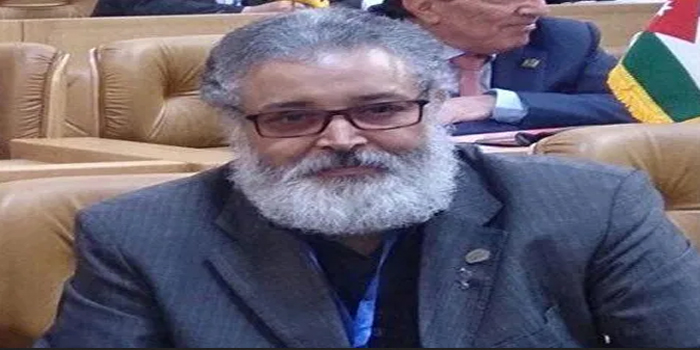كوسموبوليتيكا العدالة إشكالية مطلب
تشرين- إدريس هاني:
هل آن الأوان كي نعيد ترتيب الأوراق في أصل ومفهوم العدالة وما يسبقها وما يلحقها من مفاهيم وقضايا؟ هل بالإمكان قيام طوبى العدالة في عالم غير عادل؟ فالعالم موطئ الكثرات، ومن دخل العالم دون استيعاب التعقيد استغرقه التجريد والمثال المنفصل، بينما مقتضى الحسّ، أن لا نتجاوز المثال المتصل، وهذا التجريد والاختزال الذي شهدته حركة البندول من أقصى اللوغوس إلى أقصى الميتوس ضمن مجال ترددي مفتوح، آن لها أن ترتكس لصالح التواسط، ألا وهو استيعاب تركيب أقضية العالم المتكثر، ليس هناك حلّ مضمون، ولكن ثمة حركة وعيّ بما ليس مضموناً، ولماذا هو ليس كذلك.
ومع إنّ ميل البشرية للعدالة قد لا يشذّ عنه حتى الظّالمون لحظة فوت المنفعة الخاصّة، إلاّ أنّ النقاش فيها تشظّى حتى بات من المفارقة أن ننسج تصوراً ظالماً حول العدالة، ولا سيما مع تعقيد وضع المجتمعات الحديثة.
والخلاف فيها مسّ التعويضي منها والتوزيعي. والنقاش القانوني في آماده المختلفة، هو نقاش في العدالة، بوصفها ضامن المنفعة الأعمّ.
كانت الرؤية البدائية لمفهوم السعادة لا تتجاوز مفهوم اللذة، بالتبسيط نفسه الذي أسفرت عنه الأبيقورية في زمانها. تبسيطية نظراً لمجتمعها وسياقها، وهي اللذة التي ستستعاد في تجربة الإنكليز الاجتماعية وتجربتهم الاختزالية التي تُعد طوراً من أطوار حركة البندول في اكتساحها المجال الترددي واستقصاء وجوهه، مما يجعلها لحظة في التفكير وليس أقصاه، لكنها أبيقورية تتاح من النزعة الحسية التي أرساها دافيد هيوم، وتجد لها تطبيقاً على عنصر اللذة عند توماس هوبز، حتى ذلك الحين كانت بجاحة التجريبيين في مديح الاختزال، وأما وسائل إحراز الحس فهي الحواس الخمسة، ويبدو أنّه سيكون من المفارقة أن نقصي الحس المشترك، لأنّ المفترض من الحسية أن تجعل الحواس تشتغل في فوضى دون انتظار أو تركيب ضمن هذا الحس المشترك غير الحسّي، فالنظام يقتضي خروجاً من مقتضى وشروط الحسية، هو ما يجب أن نصطلح عليه: المفارقة الحسية.
إنّ محاولة بنثام في ترويض اللذة وتصنيفها، لهو عمل بالغ السذاجة، ولكنه عنوان سياق اعتملت فيه عوامل تتجاوز شخص الفيلسوف، ومرة أخرى أذكّر، بأنها سذاجة طور ومرحلة، فاللّذات لا حدود لها، ولكن بنثام وتحت طائلة النزعة الحسية، نزع إلى التصنيف والحساب، كل هذا سنجده قائماً عند هوبز، وكيف اختزل هذا الأخير العالم في الحساب، وكان في هذا واثقاً، فكيف لا ينزل مريد له كبنثام لإخضاع اللذة نفسها إلى حساب.
إن نحن قسونا على بنثام وقبله هوبز، فذلك لأنّ تاريخ الأفكار أهّلنا لننظر خارج فعل الاختزال، وإن ظلت بعض شظايا هذا الاختزال تقاوم تعقيد الواقع في ذهن بعض المتعثرين في طريق تاريخ الأفكار، أو لنعتبرهم خدائج في مفرخة الفكر. سنكون مدينين لأولئك المؤسسين للاختزال – وليس لمن أعادوا إنتاج اختزالاتهم في تاريخ فلسفي منكوب- لأنّهم أهلوا الفكر لمزيد من النقاش، وهم عناصر فاعلة في تاريخ الفلسفة، ذلك لأنّ كسر هذا الاختزال البثنامي سيأتي من ابن صديقه جيمس، حيث اجتمع الوفاء والنقد، أعني جون ستيوارت ميل، حيث تتأكد اللذة في مفهومها الروحي، وأيضاً بالإضافة إلى المنفعة العامة الموروثة عن بنثام، سيعزز مفهوم منفعة الأقلية.
كل هذه مقدّمة للقبض على النقاش في سياقه الحسّي الحقيقي، وأعني بذلك لحظة جون راولز، لماذا جون راولز؟ لأنّه فكّر في الواقع وتعقيداته الاجتماعية والمؤسسية، وفي سياق الأنظمة الأيديولوجية والسياسية، فهو إذن حسي بقدر ما كان الحسيون تجريديون في مقاربة المنفعة في أطوارها البدائية، ذلك لأنّ المعضلة لا تكمن في فلسفة اللذة بمعناها الأناني البدائي، فهذا ميل محسّ للكائن، وحاضر في الوعي واللاّوعي الفردي، لكن المعضلة الفلسفية تكمن في فلسفة اللذة الاجتماعية، والمنفعة العامة.
وكما جرى التقليد في العودة إلى الأسس التي لم تستنفذ أغراضها، استراتيجية إعادة القراءة، فلقد سعى راولز إلى إعادة قراءة جون جاك روسو في العقد الاجتماعي، بوصفه عقداً ضامناً للمنفعة العامة، وبوصفه أساساً لتحقق العدالة، إن راولز – في قانون الشعوب – لم يستبعد مفهوم الدولة، ولكنه حين كان يتناول مفهوم العدل الكوسموبوليتكي أو مفهوم احترام الشعوب بعضها بعضاً، فذلك لكي لا تختلط غاية ما يصبو إليه بحثه إلى مفهوم الدولة، وحين استعمل عبارة الشعوب، فهو يستعمل ما استُعمل في الميثاق الأممي نفسه: نحن شعوب الأمم المتحدة، وتكمن قيمة راولز في كونه أراد أن يخلق تركيباً خلاقاً بين أيديولوجيتين تصارعت حول تدبير المفاهيم والقوة: الرأسمالية والاشتراكية، حاول راولز أنّ يوجد تركيباً وليس جسر تفاهم فقط، يجعل العدالة مستوعبة لكل هذا الجدل، فهي عدالة لا تلغي الفوارق الطبيعية والاستعدادات، ولكنها تضمن حدّاً من التدبير المقوض للفوارق الطبقية.
وعليه:
أرى أنّ معضلتنا الكونية تتعلق بأدواء الاختزال في تفكير الإنسان الاقتصادي، وهو طور كئيب في تاريخ الأناسي، حيث اختزلت السعادة وأوكلت مسؤوليتها للاقتصاد السياسي في عالم متظالم.
إنّنا في سياق النقاش المكثف الذي عرفه مفهوم العدالة، نشعر حقاً أنّنا لسنا سعداء، إن فكرة السعادة، فكرة روحية تتجاوز مفهوم اللذة والمنفعة، فهي تنطوي عليهما نحو انطواء، لكنها لا تختزل فيهما، فهي ليست مادية محضة وليست روحية محضة، بل هي إنسانية تتقوم بهما معاً، إنّ المنفعة منذ بتنام في أسس التشريع وعند مونتسكيو في روح القوانين وعند الشاطبي في مقاصد الشريعة والشيخ الصدوق في علل الشرائع، هي منفعة عامة، فالعدالة، ليست وجود قوانين مجردة وتنفيذ صارم لها، بل الإنصاف يبدأ من تقصيد القوانين وتعليلها لتكون في الصالح العام.
في علم الكلام الإسلامي القديم اختلف الفرقاء حول العدل، وهناك من جعله من أصول الاعتقاد وهناك من أخرجه من تلك الأصول، ووجب هنا إعادة قراءة الوضعية التي كانت عليها قصة العدالة وسياقها في مناشئ الكلام وفذلكاته، فالنزاع لم يكن حول ما إذا كان الخالق عادلاً أم لا، بل هل ما يفعله عدلاً أم لا؟، فمن أثبت العدل قال إنه لا يجب عليه فعل إلا العدل، ومن قال بغير العدل، قال ما يفعله هو العدل، فكان النزاع حول «وجب فعل العدل» على من لا أحد يوجب في حقه شيئاً، غير أنّ القوم نسوا أنّهم أوردوا خبر: إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته حراماً بينكم، وهو ما يساعدنا على القول بأنّ هذا الوجوب هو مقتضى الصفة نفسها، وتظهيره في الكلام، هو مجاز لا يخلّ بالتنزيه، ولكن تثبيت العدل في الأصول، كان ضرورياً لمقاومة حركة نسبة الظلم للباري التي قامت عليها قدرية ورخصة الظلم السياسي، فضلاً عن أنّها لعبت دوراً كبيراً في التنشئة على العدل، وهذا مبحث أثير، أولى لنا أن نباشره في الكلام الجديد، بدل الولوغ في اللُّتيّا والّتي. والحق، أنّ النزاع كان بين أفهام لا بين حقائق، فهناك من فهم أن العدل هو الفعل من دون اشتراط تنزيهاً للذات، وهناك من قرره أصلاً تفادياً لهذا الفهم، فلو أن القوم أمعنوا النظر اليوم، لاعتبروا ذلك بديهياً، فكان وضعه كأصل كعدمه لا ينفي ما هو صفة لعين الذات، وليس هناك مشاحة في الاصطلاح.
عادت الرأسمالية المتوحشة، لترتدّ على كلّ التعاقدات التي فرضتها نضالات المجتمع، عادت إلى نزعتها الأبيقورية المبسّطة، والتي يمكن أن نصيغها في المعادلة التالية النقيضة للمفهوم الأثير للنفعية: أقصى اللذة والمنفعة لأقل عدد في المجتمع، بل إنّ السعادة تتراجع اليوم ليس في وجدان البشرية فحسب، بل إنّ ما نسميه بالرضى فيما فعلنا ونفعل، يثير أمامنا شواغل البيئة البشرية والطبيعية التي تنذر بالخراب، بالنزيف الذي يتهدد الإنسان وبيئته، يتهدد العقل والوجود، يضعنا أمام مصير مجهول.
إنّ العدالة مطلب شامل للجنس البشري، يسنده الحق في مستقبل سعيد للكوكب، وهو حق مهدور أمام سطوة اقتصاد سياسي ينذر بالندرة، وهذا هو أساس أزمة العدالة في النظام الدولي، يصعب معه الإنصاف – رغم وجود هيئات دولية وقانون دولي- وكذا في التوزيع، حيث ليس للأمم الحق في ثرواتها، وحيث أقلية في العالم كله تحتكر الثروة.
وفي ظلّ هذه الوضعية المزرية، هناك وهم بوجود ضوابط لتحقيق العدالة، فالعدالة من الممكن تطبيقها في مجتمع ليبرالي، وهنا أهمية محاولة راولز الواقعية، لكن ماذا عن المجتمع الدولي، وكيف يمكن لقوى مهيمنة خارج ضغط التعاقد الاجتماعي، تعتبر المصلحة بالمعنى الأناني، عدلاً؟ نحن إزاء تعقيد آخر، يتجاوز حتى التعاقد الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، لأنّ المجتمع الدولي، مجتمع دارويني بامتياز، ومؤسساته هشّة، مجتمع مرتهن لحسابات إمبريالية، هي في منطق اللذة أبقورية، وفي منطق التوزيع ميركونتيلية. كيف يمكن تحقيق العدالة الدولية بمؤسسات هشّة، في عالم تَبَنْيَن فيه الظلم وتَمَأْسَس.
منطق السعادة الوحيد والممكن والمتبقّي، هو الشعور والإحساس بمقاومة هذه النزعة الاختزالية، بتعزيز النقاش حول العدالة خارج التجريد الكلاسيكي بوجهيه: المثالي والحسّي، ليتعدّى إلى نقاش أعمّ، يشمل مستويات التدبير ومفاهيم التنمية وأسئلة الحكامة، وقبل كل ذلك، قضية تقرير المصير البشري، وهو الشكل الأكثر عدالة في نظري من كل أشكال تقرير المصير السياسي التي شكلت وما زالت واحدة من الإلهاءات السياسوية لعالم ما زال يعاني من كل أشكال الظلم، إنّ الصخب البشري الذي تحتضنه تيتانيك الاقتصاد السياسي بنكهته الإنكليزية الكلاسيكية، لم يغطِّ على أصوات النذير التي ما زالت ترسم صورة الجليد المنتصب على طريق ما يبدو لنا طريق كوكبنا السعيد.